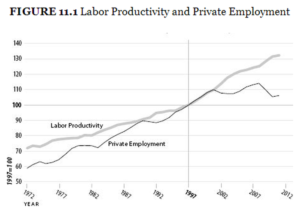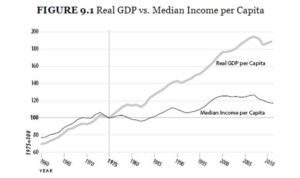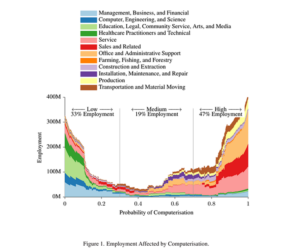مقدمة
تحياتي عزيزي القارئ لعلك تسأل من هذا الطالب الذي بدرجة مشرف؟ ببساطة هذا أنا. طالبة علم، حصلت على درجة الدكتوراه منذ فترة قريبة، والآن جاء دوري كي أكون مشرفة على أبحاث من يليني. كنت، ولا زلت، وسوف أظل طالبة علم، ولا أُعدّ نفسي من العلماء بعد، لأنني كلما عرفت أكثر، أدركت أن ما ينقصني أكثر وأكثر.
ولعلك تتساءل الآن: ولِمَ تكتبين عن نفسك؟ أو ربما أنك تتوقع مني أن أسرد قصة نجاح.
حسنًا! ربما تعدها قصة نجاح، لكنها لن تكون هي محور الأحداث أو مركز الصورة، اعتبرها الخلفية. ما سوف أرويه هو مُلخّص يوميات طالبة دراسات عُليا بإحدى الجامعات المصرية، والمغزى من وراء القصة شيئان: أولهما، أن تنظر عزيزى القارئ بمنظور مختلف لما يدور وراء الكواليس، وتدرك ما لايدركه الطالب من منظوره، وثانيهما، أن تعرف أنه لا شيء صعب المنال طالما عاهدت نفسك على التعلم، والتزمت بعهدك.
أرى عينيك تدوران، ثم تطلق تنهيدة، وتقول ليس قصة تحفيز أخرى، ما بال هؤلاء العلماء يتركون الحديث عن العلم ويتحوّلون إلى خبراء تنمية بشريّة فجأة؟
مهلًا! لا تتعجل! فهي ليست قصةً أخرى للتحفيز، إلا إذا أردت أنتَ أن تعتبرها كذلك، ووجدت فيها ما يلهمك. لست أكتب لأقول أنني حاربت الصعاب، وانتصرت على الأعداء، واخترعت مركبة فضاء، وفككت شفرة الهيروغليفية.
هي قصة مشوار بدأ ولم ينتهِ بعد. سيكون فيها كل يوم شيءٌ جديد. سأتعلم وسأحكي لكم ما تعلمته. ربما وفّرت عليك التجربة لتُغيّرَ كثيرًا من قناعات لديك.
إن كنت طالبًا، أو حديث التخرج، وتنوي عمل دراسات عليا بمصر، فدعني أعرّفك قليلًا على أشياء خارج توقعاتك، إن لم يكن لديك فكرة. وإن كنت قد اتخذت خطواتك الأولى بالفعل فربما تجد في قصّتي ما يفسر ألغازك، ويهوّن عليك المفاجآت. لن أقول لك الآن ما مجال دراستي، فرغم احتمال أن تكون دارسًا لتخصصٍ آخر يختلف عني، ولكنني أثق أن لديك نفس الأسئلة، ونفس الشكوى.
أراهنك أنك قد قلت إحدى هذه الجمل أو بعضها مرارًا:
“لا أدري فيم يكون موضوع رسالتي”، “لا أدرى مَن أختار مشرفًا”، “المشرف اختار نقطة بحث لا أحبها”، “لا أستطيع أن أقابل مشرفي بما يكفي”، “المشرف لا يقدم لي نصحًا كافيًا”، “المشرف يهملني ولا يستمع لشكواي”، “أريد أن أترك كل شئ وأسافر”، “تبًا للدراسات العليا في هذا البلد”، “لا يوجد إمكانيات”، “أريد أن أقتلَ المشرف ثم أنتحر!”
أراك تضحك، وهذه علامة جيدة.
سأحكي لكم ما حدث معي، وربما ما حدث مع زملائي أيضًا إن سنحت الفرصة، وستعرفون أن الإجابات متشابهة، وأنه لا توجد اختلافات كبيرة أو استثناءات، وأن كل ما يلزمك هو مرور الوقت مع صبر ومثابرة، حتى تتحول من خريج إلى باحث، ومن طالب إلى مشرف.
لن أطيل عليك، وتابعني في أجزاء السلسلة لتعرف أكثر، وتضحك أيضًا.
البداية
من أين أبدأ؟ هذا سؤال محير! لكنني أود أن أبدأ منذ لحظة تخرجي لأن في كل مرحلة أرويها هناك عبرة.
تخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 2003 من قسم الإلكترونيات والاتصالات الكهربية. وكنت من المتفوقين في دفعتي، فقد تخرجت بدرجة امتياز، لكنني لم أعين بالكلية، والتحقت بمنحة طلاب البحث التي تقدم للخريجين لمدة عامين بعد التخرج للحصول على درجة الماجستير. وبهذه المنحة كان أمامي خيارين: إما أن أقوم بالتدريس كمعاون لبعض الأساتذة، أو أن ألتحق بشركة بحثية ناشئة، أسسها بعض الأساتذة من قسمي، داخل مركز بحثي خاص في جامعة القاهرة.
وقد اخترت الاختيار الثاني فلم أكن شغوفة بالتدريس حينها. وما هي إلا شهور قليلة، حتى فتح باب التقدم للدراسات العليا والتسجيل لدرجة الماجستير. ووجدت أن لدينا بقسم الاتصالات عدة مجالات متخصصة للدراسات العليا: الاتصالات – اتصالات الحاسب – الإلكترونيات – الموجات – التحكم. وحينها وجدتني في حيرة من أمرى. كيف أختار مجالي ومشرفي؟ وفيم يكون موضوع رسالتي؟.
ولكن حيرتي لم تطل طويلًا. فقد كان لزامًا علىّ أن آتي بموافقة من رئيس المركز البحثي، بمنحي يوميّ تفرغ للدراسة بما أنني مهندس حر. وحين ذهبت إليه لم يطل النقاش، فقد قال لي “قطعًا سيكون مجال دراستك هو الاتصالات لأنك ستسجلين للدرجة مع مشرف من الشركة وكلهم من ذاك التخصص”.
لا أخفي عليك فقد شعرت بالإحباط، لأنني لم أتخيل أن الدراسات العليا ستكون كالدراسة الجامعية محدودة الحرية في الاختيارات. وقد كنت أميل حينها إلى دراسة تخصص اتصالات الحاسب. ولكننى استسلمت للأمر وسجلت للدراسة في تخصص الاتصالات. مستغرب! أليس كذلك؟ ما الفرق إذًا بين تخصص اتصالات واتصالات الحاسب؟.
لا ليس كلمة “حاسب”. فهذه ليست مزحة.
هو فارق أبسط بكثير من كون المواد الدراسية في مجال اتصالات الحاسب مختلفة، وتتجه أكثر نحو تطبيقات الحاسب.
الفارق ببساطة أن مجال الاتصالات كان مشهورًا برسوب كل من يلتحق به!
أجدك تضحك!
نعم هذه حقيقة معروفة تتوارثها الدفعات. فهذا المجال يلتحق به المعيد الذي يدرس مادة “الاتصالات” للطلبة، وهو الوحيد الذي ينجح، وكل من سواه في هذا المجال يرسب. لذا لا يتعدى الملتحقين به كل عام سوى 6 أو 8 أفراد ممن لا يعلمون ذلك أو يجدون في أنفسهم الجرأة للرسوب!
كعادة الطالب المتفائل اعتبرت نفسي لم أسمع شيئًا. أمسكت بدليل الدراسات، وقرأته، وبدأت أفهم أسلوب الدراسة، وأعرف أسماء المواد، وأخطط ما سوف أدرسه. ففي وقت دراستي بقدر ما أذكر كنت أدرس في كل فصل 8 مواد منها مادتين اختياريتين، وامتحان واحد بنهاية العام. وبالسؤال عن جدول المحاضرات لتقديم الرغبات، اكتشفت أن المواد الاختيارية المتاحة 3 فقط، وليست تلك القائمة الطويلة من الأسماء الجذابة المدرجة في الدليل! وبالتالي للمرة الثانية لا أجد مجالًا للحيرة. ببساطة سأختار المادتين الأقرب لتخصص المشرف الذي سأسجل معه، بصرف النظر عما إذا كنت أريدها أم لا. وتركت مادة لا أعرفها، ولكن يعجبني أنه كان يدرسها واحد من أكثر الأساتذة تمكنًا في القسم، وكنت أحبه وأقدره بشدة رغم قسوته المعروف بها بين الطلبة.
حينها قلت لنفسي “أخيرًا انتهت المفاجآت، وحانت البداية، وسوف أقوم بالمعجزات”
يمكنك الضحك. فقد كنت مسكينة لا أدري ما كنت مقبلةً عليه.
بدأت الدراسة، ووقعت في الفخ! كانت سنة دراسية في منتهى الصعوبة. فقد كنت لشهور متواصلة أستيقظ في الثالثة فجرًا، وأذاكر ثلاث ساعاتٍ، ثم أقوم بطهي الغذاء وإعداد الإفطار لوالديّ، وأخرج للعمل مُبكرًا بحيث أكون داخل الشركة الساعة الثامنة صباحًا. كنت أعمل فيها حتى الرابعة عصرًا، ثم أجري للحاق بالمحاضرات التي تبدأ الخامسة، وقد تنتهى الساعة السابعة أو التاسعة مساءً، وأعود منهكة لأنام 5 ساعات على الأكثر، ثم أستيقظ لأعاود الكرة. ولم تكن نهاية الأسبوع تختلف كثيرًا عن الأسبوع نفسه: ما بين عمل متأخر للشركة، ورعاية لشئون المنزل والوالدين، ومذاكرة للمواد التي تختلف كثيرًا عمّا درسته في المرحلة الجامعية، الفارق الوحيد أنني كنت أرى فيها والدىّ، لأنني بالأيام العادية كنت أستيقظ وأخرج قبل أن يستيقظوا وأعود لأنام وهم مستيقظون. حتى أن أمّي في أحد الأيام فجرًا، جاءت وجلست بجانبي تتأملني. فسألتها ما الأمر؟، قالت “لم أركِ منذ 3 أيام”!
الحق أقول أن الوضع كان متأزمًا حقًا، وكنت أخشى الرسوب! نعم، لا تندهش أن تكون متخرجًا بامتياز، وتخاف من الرسوب. ما بين ضيق الوقت لانشغالي بالعمل والتقدم فيه، ورعاية أسرتي، وعدم وجود وسائل مساعدة للدراسة.
لا وسائل مساعدة؟
نعم! ألم أقل لك؟
قط ما تستطيع كتابته في المحاضرات والمرجع الذى يرشحه أستاذ المادة، هذا كل شئ. لا يوجد من تسأله ولا تعلم ان كنت ما تفهمه صحيحًا أم لا. اعتماد كامل على النفس. لم يكن هناك في ذلك الوقت يوتيوب، أو محاضرات تفاعلية على الإنترنت، أو حتى وسائل للحصول على كتب أخرى أفضل من المراجع المقررة، الغير مفهوم أغلبها وتلك العتيقة الملقاة على أرفف مكتبة الكلية. لم يكن هناك دروس خصوصية، ولا معيدين نلجأ لهم في فهم ما يتعسر علينا، أو حتى طلبة سابقين نعرفهم. أنت الآن شخص مسئول، نظم وقتك، رتب أولوياتك، تقبل واقعك، وتعلم ألا ترفع سقف توقعاتك، فالمتاح ليس بقدر ما تريد.
حسنًا لعلك تقول فلنجتهد في المذاكرة فحسب وسننجح.
ليس بتلك السرعة! تريد أن تعرف كيف يمكن أن تذاكر وترسب؟
ستعرف في اليوميات القادمة.
ولكن دعني الآن أُلخّص لك العبرة فيما قرأته: “ليس كل ما تريده تحصل عليه في حينه، وربما لا تحصل عليه أبدًا ولكن ثق أن اختياراتِ الله لك دومًا هي الأفضل”.
أمتحانات الماجستير
توقفنا في اليوميات السابقة عند الوضع المتأزم الذي أشعرني بالخوف من الرسوب في دراستى العليا، نظرًا لتصاعد الصعوبات كل يوم مع مسئوليات الحياة والعمل، ووعدتكم أنني سوف أكشف لكم أمرًا يفاجئكم عن أسباب الرسوب.
لعلك تظن الآن أن النجاح والرسوب ترجع أسبابه إليك فقط. دعني أفاجئك إن قلت لك لا! فهناك أسباب أخرى لا علاقة لها بك.
حسنا لنعُد مرةً أخرى إلى محاضرات الدراسات العليا. لعلكم كنتم تذكرون أنني كنت أميل لدراسة مجال اتصالات الحاسب الذي كان مرغوبًا أكثر من مجال الاتصالات، ويسجّل فيه عدد كبير من الطلبة، في حين يفرون من مجال الاتصالات المعروف بمجال “لم ينجح أحد”. وأنني أرغمت على عدم اختياره وقد استسلمت لذلك. هوّنَ عليَّ قليلا وجود مادة مشتركة نحضرها مع من يسجلون في مجال دراسة اتصالات الحاسب. وفي إحدى المحاضرات قرب الامتحان النهائي إذا بأستاذ المادة يقول “لابد أن تعرفوا مسبقًا أن الامتحان سيأتي صعبًا جدًا وربما معجزًا، أتدرون لماذا؟ ببساطة لأن عددكم يتجاوز الـ 250 طالبًا ونحن بالقسم في هذا المجال 6 أساتذة فقط. ومن ينجح منكم لابد أن يكونَ له مشرف. وبالتالى فإننا لا نستطيع ذلك”!
وقتها شعرتُ بألطاف الله حين أرغمت على التسجيل في مجال لا يطرقه الكثيرون. وعلمت أن فرصتي في النجاح ربما تكون أكبر، لأنني سأعاني من صعوبة امتحان مادة واحدة هي المادة المشتركة، لكن لدي الفرصة في أن أعبر بسلام من الامتحانات الأخرى. ولكن ذلك أيضًا فتح عيناي على أن التنافسية شديدة جدًا، وعلىّ أن أتفوق بأيّ صورة؛ فللرسوب أسباب أخرى غير إهمال الدراسة، ولابد لي من موقفٍ حازم إذا أردت النجاح خاصة وأن وسائل المساعدة غير متوفرة.
وللمرة الثانية أشعر بجميل اختيار الله حين أردت التفرغ للدراسة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الامتحانات التي تأتي قبيل موعد امتحانات الطلبة بالجامعة. فاستطعت أن أحصل على شهر كامل إجازة من العمل بالشركة، بالإضافة لأسابيع الامتحان، وهو ما لم يتحقق لزملائي من المهندسين بها لأنهم لم يكونوا طلاب منحة مثلي، وكانوا يحصلون على يوم إجازة قبل الامتحان ويعودون للعمل بعد الامتحان مباشرة! وهو أيضًا ما لم يتوفر لطلاب المنحة زملائي الذين اختاروا العمل بالتدريس، لارتباطهم بالطلبة والامتحانات الجامعية التي تلي امتحانات الدراسات العليا مباشرةً.
لله الحمد على ما أنعم به عليّ. حقًا اختيار الله هو الأفضل!
قضيت شهرًا في معسكر مغلق، أحاول بكل الوسائل لمَّ شتات المواد التي أدرسها في ظل الموارد المحدودة، ودخلت الامتحانات التي، ولله الحمد كانت كلها صعبة، لكن فضل الله كان عظيمًا، ونجحت واثنين من زملائي (منهم المعيد طبعًا وطالبة بحث أخرى تعمل بالتدريس)، مما يجعلنى الوحيدة من خارج الكلية التي نجحت في اختبارات مجال الاتصالات، بينما رسب الستة عشر طالبًا الباقون كما يتوقع الجميع!
والحق يقال أنني لا أنسى فضل والدتى في دعمها لى، وصبرها علىّ، رغم مرضها واحتياجها للرعاية والاهتمام المستمر. وبعد هذه التجربة كان علىّ أن أعيد ترتيب أولوياتى. الأمر اختلف الآن وسوف أدخل مرحلةً جديدة من حياتي، وأتحول إلى البحث العلمي، وكنت أعلم أن بقائي بالشركة لن يتيح لي التفرغ المنشود للدراسة والأسرة. وتقدمت لإعلان طلب باحثين بمركز بحوث حكومي، وكنت على رأس قائمة المقبولين. لا أخفيك سرًا أنني كنت حزينة؛ لأنني أردت أن أستمر بالعمل بالشركة التي ألفتها، مع زملائي الذين أحببتهم، وكنت أتعلم فيها جديدًا كل يوم. لكنني كنت أعلم أنني شغوفة بالبحث أيضًا، وتعلمت أن بالحياة أولويات لابد أن نقدرها. خرجت من الشركة على وعدٍ لرئيسها بأنني سوف أعود بعد سنة، وأنني أنوي أن أبذل كل ما في استطاعتي لإنهاء بحثي ورسالتي في هذه السنة.
تريد أن تعرف إذا كنت قد تمكنت من ذلك أم لا؟
ستعلم في اليوميات القادمة ولكن دعني الآن أُلخّص لك العبرة فيما قرأته: “ليس كل فشلٍ أو رُسُوب أو قرار بالتخلي في حياتك راجع لإهمالك. لكن تدابير القدر تحرك الأحداث من حولك وتسير بك إلى ما أنت مخلوقٌ له. وربما تظن أنك قد أُجبرت على الطريق الأطول، لكن كن على ثقة بأن الله قد اختار لك الطريق الأسهل!”
الوظيفة البحثية
توقفنا في يوميات 3 عند خروجي من الشركة، وتركي لمنحة طالب البحث، والتحاقي بوظيفة بحثية حكوميّة، وكما ذكرت فإن ذلك كان بسبب ترتيب أولوياتي، كي أتمكن من التركيز على دراستي العليا ورعاية والدتي بشكل أفضل، وليتاح لي مزيدًا من الوقت معها.
هذا هو القرار الأمثل دون شك. “الآن أصبحت لدي الحرية أن أختار مشرفًا من خارج الشركة، وأن أختار الموضوع الذي يعجبني للبحث فيه”. “قطعًا سأجد كل المساندة في مركز بحثي أكثر من شركة تعمل على مشروع موحّد قد يكون بعيدًا عن نقطتي البحثية”. “لن يكون هناك إجبار لأن المركز البحثي فيه اتساع للتخصصات”. هذا ما كان يدور بذهني عندئذ.
وكان لالتحاقي بهذه الوظيفة مفارقة عجيبة. عندما أعلن عن الوظيفة كان الاختيار أمامي بين عدة أقسام، لم أفهم من التخصصات المذكورة سوى قسم واحد، فتقدمت إليه وتم قبولي. وعند استلامي للعمل، ذهبت لرؤية رئيسة القسم حينها، ومشرفتى لاحقًا. وبمجرد أن عرفتها بنفسي قالت “حسنًا سأكون أنا مشرفتك وسيكون دكتور فلان مشرفك من الكلية”.
لك كل الحق أن تضحك طبعًا.
متى سيكون لى الحق أن أختار أي شيءٍ في هذه القصة؟
لم أكن قد تعاملت مع هذا الأستاذ سابقًا، وبالتالي لم يكن لدي الكثير من المعلومات. فسألتها إن كان من الممكن أن ترشح لي اختيارات أخرى بحيث إن رفض الأستاذ نقطة بحثي، أو كان مكتفيًا بطلبته، أستطيع الذهاب لأستاذ آخر، وكانت الإجابة “لا تقلقي فهو يشرف على كل تلامذتي”!
حسنًا، لم يعد لدي أي شيءٍ أفعله كالعادة. وبحثت في قائمة من الاختيارات للمواضيع البحثية، التي يعمل بها كليهما ووجدتها متنوعة، ولها تطبيقات حديثة وتبدو جذابة. وعليه فقد توجهت إلى مشرف الجامعة، لأرى ماذا سنستقر عليه. فبعد أن استقبلني ونظر في القائمة قال “أنا حاليًا لست مهتمًا بتلك المواضيع وإن أردتِ العمل معي فعليك العمل بنقطة بحثية أخرى”! وحددها في بضع كلمات.
لم أستطع النطق. وقلت أنه أكيد سيكون لمشرفتي موقف آخر.
عدت إلى مشرفتي وشرحت لها أنه اختار شيئًا جديدًا، وأنني لا أعلم عنه أي شيء، وأنني لم أجد من زملائي بالمعهد والحاصلين على الدكتوراه من يستطيع مساعدتي، أو يعلم شيئًا عما طلبه. فوجدتها غير معترضة، وأعطتني كتابًا لأبدأ منه في التعرف على بعض الأساسيات، وقالت ببساطة أنني سوف أتعلم وحدي!
استسلمت للأمر وبدأت في قراءة الكتاب، وبقليل من البحث عن النقطة المطلوبة اكتشفت أنني كنت سأوفر على نفسي جهدًا كبيرًا ان كنت درست تلك المادة الاختيارية التي تركتها بالسابق، وكنت أقدر أستاذها، بسبب أنها بعيدة عن تخصص المشرفين من الشركة التي تركتها! بل إن كل المواد التي درستها في السنة التمهيدية لا تمت بأي صلة لنقطة البحث!
أرجو ممن يحاول أن يتخيل شكلي وقتها أن يتوقف عن الضحك.
ماذا سأفعل هل أعترض لأنني لن أجد مساعدة ولأني لم أرَ أحدًا قد عمل بهذه النقطة البحثية سابقًا، ونتائج البحث على المحركات لا تقدم مساعدة كافية؟ هل سيكون المشرفين مساندين لى ويقدمون لي الدعم ؟ هل العمل على نقطة بحث غير شائعة فرصة جيدة ودافع للتحفيز أم أمر محبط؟
تريد أن تعرف ماذا فعلت؟
ستعلم في اليوميات القادمة، ولكن دعني الآن ألخّص لك العبرة فيما قرأته: “الحياة ليست بها ضمانات وغالبًا ما ستتغير خططك وتجد الواقع عكس توقعاتك .. لا تُحبط”
موضوع البحث
توقفنا في اليوميات السابقة عند موضوع البحث الذي اختاره مشرف الجامعة، ووافقت عليه مشرفتي، ووجدت أنه موضوع غريب لا يعمل به أحد في المركز البحثي، ولا يستطيعون مساعدتي فيه. وكنت في حالة من الارتباك هل أرفض العمل به؟ أم أنه من الجيد أن تعمل بموضوع جديد نسبيًا؟
هبت لمشرف الجامعة وتحدثت إليه بصراحة، وقلت له أنني لا أجد أي مساعدة وأريد تغيير الموضوع. فما كان منه إلا أن قال “لا عليكِ، سوف أساعدك بنفسي، وإن لم أستطع فسأوجهك لمن يقدر على ذلك”. وأسقط في يدي فلم أستطع النطق. قلت في نفسي “أنا لم أسمع شيئًا عن المشرف قبل ذلك، فربما سيذلل لي الصعاب فعلًا. لن تضيرنى التجربة”. فوافقت على الاستمرار بالموضوع. فما كان منه إلا أن طلب مني إعداد تقرير عن كل ما أعرفه حول الموضوع، وعمل مسح مبدأي للأبحاث المنشورة فيه!
عم، لا تستغرب. تلك هي المساعدة التي يقدمها المشرف عادة!
خرجت من المكتب أجرجر أذيال الصدمة لا الخيبة. فقد كنت متخيّلة من وجهة نظر الطالب أن معنى “أساعدك” أن يجلس معي ليشرح لى ما هذا الموضوع؛ لأن ما قرأت عنه حتى تلك اللحظة كان مهلهلًا. فلازلت لم أتعلم بعد كيف أبحث عمّا أريد بشكلٍ احترافي، ولم تكن لدي حتى الأساسيات، فقد درست موادًا تمهيديّة لا علاقة لها بذاك الموضوع!
عدت للبحث على الإنترنت مرة أخرى لعلي أجد ضالتي. وبعد مدة من القراءة في ملفات لا أفهم ماذا يربطها ببعضها سوى ورود الكلمة التي أبحث عنها بالعنوان، وقعت على مسح survey يفصل الموضوع من جميع جوانبه في حوالي 30 صفحة. لا أستطيع وصف سعادتي بهذه الورقة البحثية. كانت كالكتاب الأول في هذا الموضوع. نسيت أن أذكر لك أنه في ذاك الوقت لم يكن هناك كتب تتحدث عن هذا الموضوع، ولكن بعد سنوات اهتمّ الباحثون بتأليف كتب عديدة مخصصة له!. أعددت التقرير، وأرسلته للمشرف على البريد الإلكتروني، وطلبت منه موعدًا للاجتماع.
ذهبت للكلية ودخلت المكتب وألقيت التحية، فقال لى “من أنتِ؟”
أعتقد أن فمى كان فاغرًا من المفاجأة!
تداركت الموقف، وعرفته بنفسى، وذكرته بالموضوع، وبالتقرير الذي طلبه، وبالطبع لم يقرأه. وبدأنا الحديث وشعرت أنه سعيد بأنني أعرف عن الموضوع، وأعطاني كتابًا أقرأه يساعدني في تعلم الأساسيات التي تؤهلني للعمل في الموضوع البحثي لاحقًا. وقال “حينما تفرغين منه تعالي”.
رجعت للقراءة المملة مرة أخرى في أساسيات لم أدرسها، لا في فترة الجامعة، ولا في السنة التمهيدية. ولا أجد من أسأله فيها. للمرة الثانية لم يكن هناك وسائل تعليمية مرئية حينها. عدت إليه في يوم آخر بعد ملل شديد وكالعادة لم يعرفني! وشكوت له أنني أملّ من القراءة بلا هدف وأن الموضوع البحثي كان فرعًا كاملًا من العلم ولم يكن نقطة محددة فلست أدرس ما المطلوب منى تحديدًا.
طلب منّي حينها أن آخذ مسألة صغيرة وأحاول أن أحلها لأتدرب أثناء القراءة وأتعلم من أخطائي فوافقت. وبدأت العمل حينها وقررت أن أذهب إليه بالنتائج كل أسبوعين حتى لا ينساني، وظننت أنني أخيرًا حددت نقطة البحث، وكنت متحمسة جدًا. وفي كل اجتماع كالعادة. كانت المفاجآت تتوالى!
في كل مرة يرفض ما تم اقتراحه بالمرة السابقة، ويقترح مهمات أخرى في حل المسألة!
حسنًا، لا تضحك! لم تكن تلك هي النقطة البحثية، وبعد كل هذه التجارب كان فقط تدريبًا، فقد قال لي أنه لا زال يفكر في النقطة التي سنتناولها!
نعم، عادة يقوم المشرف بطلب مهمات متفرقة، لا علاقة لها ببعضها، ولا علاقة لها بنقطتك البحثية؛ لكي تتمرن بأسلوب غير مباشر على طريقة البحث العلمي. تتعلم بالتكرار وبالأخطاء وبالمشكلات التي تعترضك وتحاول وحدك أن تبحث لها عن حل.
ورغم الشعور بأن تلك الأيام من العمر قد أهدرت، لكن يكفي أن هذه التجارب أدت إلى تمكني من فهم الموضوع بالتطبيق، ومنها صدرت أول ورقة بحثية لي، نشرتها في مؤتمر محلي متخصّص، وكنت في قمة الارتباك والعصبية، فقد كانت أول مواجهة لي مع الجمهور، والذي يجلس مشرفي في قلبه.
موقف لا أحسد عليه. وسيعلمه كل من واجه جمهورًا من الباحثين لأول مرة.
أن تستجمع شجاعتك وهدوءك لعرض عملك، والإجابة على الأسئلة، لم يكن أمرًا سهلًا. ولا أدّعي أنني قد أفلحت فيه، لكن ثقتي فيما عملته بيدي، قد أعطاني شجاعة كافية للرد على الأسئلة، ومواجهة رئيس الجلسة والحضور.
والآن ماذا عن نقطة البحث؟
تريد أن تعرف ماذا كانت؟
ستعلم في اليوميات القادمة ولكن دعني الآن ألخّص لك العبرة فيما قرأته: “دور المشرف هو التوجيه فهو لم يعد أستاذك بالكلية، لن يشرح لك الأساسيات، ولن يطرح لك حلولًا لمشاكلك البحثية، أو يقترح عليك أسلوب الحل. دور المشرف ينحصر في أن يتأكد أنك قد فهمت مجال بحثك، وفهمت أسلوب البحث العلمي، وأن لديك من الحجة ما يمكنك من الدفاع عن عملك. فلكي تتحول من طالب إلى باحث .. ساعد نفسك بنفسك”
نقطة البحث ١
توقفنا في يوميات 5 عند الورقة البحثية التي نشرتها من المسألة الأولى في موضوعي البحثي، والعبرة من ذلك الوقت المهدر في التمرين، الذي لابد منه لتتمكن من فهم موضوعك دون مساعدة مباشرة من المشرف الجامعي. ولكن ذلك لم يحدث بنفس الترتيب، فإنني لم أنشر تلك الورقة إلا قرب نهاية العمل بالرسالة. وطوال الوقت، كنت لازلت في تلك التجارب التي لا أعلم إن كانت ستودي بي إلى نقطة البحث في النهاية، أم أنها ستتوقف عند مرحلة التمرين.
والحق أن خلال تلك الفترة، لم أكن أعي حقيقة دور المشرف جيدًا، لأنه على الصعيد الآخر من الجامعة، كانت مشرفتي من مركز البحث، تتابع تطوراتي بصورة أكبر من مشرف الجامعة، بحكم أننا في نفس المكان. لم تكن هي الأخرى تشرح الأساسيات أو تحل المشكلات، ولكن النقاش المستمر، كان يؤدي إلى نوع من العصف الذهني، يساعد بشكل كبير على التفكير في الاتجاه الصحيح.
لعلك تظن أن ذلك يعنى وجود فارق في أسلوب الإشراف بين المراكز البحثية والجامعات. وأن الاكتفاء بالتوجيه عن بعد ليس هو القاعدة بل هو الاستثناء.
لا، ليس تمامًا. ولكن هناك فارق بين طالب وآخر، بينما لا توجد فروق كبيرة في أسلوب الإشراف بين المشرفين. فقد حبانى الله بميزة قوية جعلتني أحصل على اهتمام المشرفة لا إراديًا.
لا، ليس الذكاء، ولا التفوق، أتعلم ما هي؟
الملازمة والتطفل.. أو كما يدعونها بالعامية “اللزقة والزن”
لا تضحك فهي ميزة قوية جدًا مع المشرف المصري، خاصّةً إذا كان لديه الاستعداد لذلك.
كنت كل صباحٍ أذهب إليها وألقي التحية، فتسألني ماذا فعلت فأحكي لها، أو أعطيها تقريرًا مكتوبًا، وكانت باستمرار تعلم كلّ كبيرةٍ وصغيرةٍ عما يجري، بعكس مشرف الجامعة الذي كان لا يحب التفاصيل، ويفضل الحديث عن النتائج، خاصّة إن كانت جيدة، فكنت لا أقابله كثيرًا لأنني أنتظر تحسن النتائج. أما مشرفتي، فكنت دائمًا في مكتبها إن لم أكن على مكتبي.
وقد كان لذلك مردودٌ واضح على عملي. وتقدم ملحوظ.
لا ليس في البحث العلمي .. بل الأعمال الإدارية.
لا تضحك! تلك هي النتيجة الطبيعية للتطفل. فقد كنت دائمًا متواجدة، والأقرب إليها، فبالتالي أكون المرشحة الأولى لتجميع البيانات، وكتابة التقارير، وإبداء الرأي والمقترحات. أو كما يقولون في الأفلام “الذراع الأيمن”.
والحق أن ذلك أعطانى امتيازًا في أن تجعل في وقتها متسعًا أكبر لتقرأ تقاريري الدورية، التي لم تكن تطلبها بالمناسبة، فهي تعلم كل التفاصيل شفهيًا، لكنني بطبعي منظمة جدًا، فكنت أحرص على كتابتها، وكانت تعلق عليها أحيانًا، مما ساهم بشكل ملحوظ جدًا في تحسن لغتي، وأسلوبي في الكتابة الفنية للتقارير والأوراق البحثية، وزيادة قوة ملاحظتي بشكل كبير. وأعطاني فكرة واسعة عما يدور داخل المركز البحثي، فقد كنت أسأل في كل شيء وعن كل شيء، واندمجت بين أعضاء قسمي، فحدثت بيننا ألفة سريعة، وأصبحت شخصيةً معروفة لدى زملائي وموظفي الإدارات والسعاة أيضًا.
لا تضحك! فموظفي الحكومة والسعاة غالبًا يمدون يد العون قبل الباحثين في الغالب.
وأقول لك سرًا ليس بسرّ. إن كلمات قليلة بشكل مستمر مع ابتسامة ودودة، أو تعبير وجه مضحك، يكون له أثر السحر في علاقتك بالآخرين. فإن اعتدت على تحية الصباح يوميًا، أو المباركة بالأعياد، أو سؤال كيف حالك؟، دون انتظار إجابات حتى، يكسر الحواجز بينك وبين الآخرين، ويجبرهم على احترامك، ويشعرهم باهتمامك، دون قصد أو مجهود منك.
جرّبها. وعلى مسئوليتي!
حسنًا! لنعد لموضوعنا.
كل ذلك ولم تتحدد النقطة البحثية بعد. حتى كان في أحد الاجتماعات مع مشرف الجامعة عام 2005، وجدته يحضر جهاز حاسب لوحى Tablet PC يمتلكه، ولم أكن قد رأيت شيئًا مماثلًا له قبل ذلك. وبدأ يشرح لى تطبيقًا عليه، يحوّل الكتابة الإنجليزية (الكلمات) على سطحه بالقلم handwriting إلى خط مطبوع printed typing بالتعرف على رسم القلم وتحديد ما يقابله من كلمات اللغة Online Handwriting recognition، وانتهي في شرحه بأننا نريد أن نفعل نفس الشيء للغة العربية. لن أمازحك إن قلت أننى كنت الوحيدة ضمن طلابه، وربما كنت الوحيدة في مصر أيضًا، التي تعمل في تلك النقطة البحثية في ذلك الوقت على كلمات اللغة العربية!
تحمست للفكرة. ليس فقط لأنها غريبة، ولكن لكم التحدي الموجود فيها، ولأنني أردت دومًا أن أفعل شيئًا لخدمة لغة القرآن. ولكن هناك مشكلاتٍ كثيرة تقف أمامي. أريد عيناتٍ للكتابة للعمل عليها، فبدون عيناتٍ لا أستطيع إجراء البحث. أريد حاسبًا لوحيًا وتطبيقًا عليه لتجميع العينات، أريد تجميعها من عدد كبير من الأشخاص، ومعالجتها قبل الاستخدام إلخ.
من أين لي كل ذلك؟ ولا أحد يعاونني.
تريد أن تعرف ماذا فعلت؟
لا تتعجل! ستعرف في اليوميات القادمة، ولكن دعني الآن ألخص لك العبرة فيما قرأته: “تستطيع أن تجبر الغير على الاهتمام بك إن أردت ذلك، وداومت على محاولاتك في جذب اهتمامه، فإنك لا تدرك قوة العادة. فإن اعتدت على فعل شئ، أصبح جزءًا متأصلًا منك، تؤثر به في الغير، ويؤثّر عليك بالتبعية، حتى وإن كان كلمة ‘صباح الخير‘. عبّر عن نفسك، وتكلم واسأل، ولا تخشى الخطأ أوسوء الظن، فالجهل بالأمور يؤدي إليهما حتمًا”
نقطة البحث ٢
توقفنا في يوميات 6 عند النقطة البحثية الجديدة، التي تبعث على الرهبة لكونها أرض جديدة تمامًا، لكنها تعزف على أوتار القلب لكونها تمثل الهوية ولغة الوطن.
لعلك تتخيل الصراع الدائر بداخلي، ما بين فكرة تعجبني، وصعوبة التنفيذ إن لم يكن استحالته. ولكنني لم أيأس، واتبعت شغفي، وأخلصت النية لله، وبدأت المحاولات.
بدأت إجراءات طلب شراء الجهاز من خلال العمل. وحصلت عليه، في غضون 3 شهور، وهي مدة قياسية لمن يعرف إجراءات شراء الأجهزة في الجهات الحكومية فذلك توفيق من الله تعجز عن وصفه الكلمات وإلا كان تأخر البحث أو توقّف تمامًا.
خلال ذلك الانتظار كنت لازلت في مرحلة التمرين بالمسألة الأولى، وقراءة مستمرة حول النقطة البحثية، ومحاولة لتجميع موارد علمية كأبحاث ورسائل مرتبطة بالموضوع للغات أخرى. ومحاولة لإيجاد تطبيق يمكنني من جمع العينات. أكرمني الله بأحد المهندسين، الذي اقترح على أداة مجهولة للرسم، يمكن تطويرها لجمع العينات. لكن لم تكن لدي خبرة في البرمجة المتقدمة التي تمكننى من ذلك.
وبمجرد الحصول على الجهاز، بحثت طويلًا عن مساعدة متخصصة، ثم اهتديت لمهندسٍ آخر استطاع أن يطوّع الأداة كما أريد. وبدأت في تجميع فقرات من الجرائد والكتب، لأمليها على الأشخاص الذين سوف أجمع منهم عينات الخطوط.
انتهى الجزء الشاق، وبدأ الجزء الممتع.
أو هكذا ظننت!
حسنًا! لنرى.
قضيت 3 أشهر أخرى أذهب للعمل، وأدور على الأقسام، أحمل الحاسب، والفقرات المنتقاة وأجلس مع من يتطوع بالكتابة عليه، أشرح له الموضوع، وأمليه عدة فقرات.
حسنًا! مسموح لك بالضحك الآن. فقد رأيت ما لا يخطر على قلب بشر!
رأيت من يمسك القلم كمشرط العملية الجراحية أو ريشة التلوين. ورأيت من يكتب بخطوطٍ لا تقرأ بالعين المجردة، فكيف بالله عليك يستطيع الحاسب التعرف عليها. واكتشفت أن نسبة الأخطاء الإملائية للباحثين، لا تختلف عن نسبتها بين طلبة المرحلة الابتدائية. ووجدت أن الباحثين يجدون متعة لا تقاوم، في الكتابة بين السطور لا على السطور نفسها، فتتحول شكل الصفحة كشكل النوتة الموسيقية. ناهيك عن معزتهم للخط العربي، التي تجعلهم يسحقون الميم تحت اللام، ويجرجرون الراء في الكلمة الأولى، لتعانق توأمها التي اختطفت لحظة الولادة، ولم تجدها إلا بعد مرور حروف، في نهاية الكلمة التالية. لا تتحدث عن النقاط فوق الحروف. فهذه مواضيع ثانوية، ثم أن العرب قديمًا، لم يستخدموا النقاط في الكتابة أصلًا. استغفر الله من تلك البدع!
لم أكن أعلم أن الكتابة العربية “رشيقة” حرفيًا. تمارس التمارين الرياضية فتجد الحروف تميل في كل الاتجاهات يمنى ويسرى ويشق عليها أن تقف مستقيمة. واكتشفت أن الميم الأخيرة لا تجد راحتها على السطر أبدًا، وتكون سعيدة بتسلق الألف التي تسبقها. والألف في أول الكلام، عار عليك إن لم تكتبها تحت اللام التي تليها. أتبدل أصول الكتابة يا رجل؟!
رأيت أشكالًا للحروف لم أتخيلها في حياتي تشبه تعازيم الأحجبة، أيقنت بها حقًا أن المصري الحديث يعتز بحضارته الفرعونية، وأن لغته الأم هي الهيروغليفية. لا تتعجب إن رأيت حرف الدال أكبر من حرف اللام في نفس الكلمة، أو أن حرف الصاد يتكون من دائرة بغير سن. أما عن طرق كتابة الحروف نفسها، وذلك أحد متغيرات المسألة، فحدِّث ولا حَرَج. لأوّل مرّةٍ أعرفُ أنّه يمكنك كتابة حرف الـ”ط” كاملًا دون أن ترفع يدك لتضع الألف، وأن الـ”واو” أو “الميم” يمكن كتابتهم عكس اتجاه عقارب الساعة!
من الجيد أنك تحاول التخيل أو تجربة إمكانية ذلك!
أريدك أيضًا أن تتخيل شكلي، وأنا أفحص العينات بعد رجوعي من العمل يوميًا، وأتأمل أداة الرسم وهي تعيد أسلوب الكتابة. أعتقد أن ذلك هو تعريف الكوميديا السوداء. فكنت لا أدري أأبكي أم أضحك. هل تلك هي الكتابات التي يفترض بى التعرف عليها آليًا على الحاسب! لقد كنت أجلس مع كل كاتبٍ حوالى ساعةً كاملة ليُجرّب قدر المستطاع قبل أن أحصل منه على تلك العينات النهائية التي سأعمل عليها. لقد هرمت وهم يحاولون.
لله الأمر من قبل ومن بعد.
استغرقت أكثر من شهر لمعالجة وتنقيح البيانات يدويًا. أحملق في الشاشة ساعات متصلة، أحاول فك التشابك وفض النزاع بين الكلمات، أو إزالة التوقيعات التي كان يحب بعض الكتاب إضافتها للنوتة الموسيقية، دلالة على فخرهم بهذا الحدث التكنولوجي المذهل، واستبعاد العينات التي لا أمل فيها، فلابد أن ألجأ لأصحابها لأعرف ما ترجمة تلك اللغة المكتوبة.
حصلت على العينات وبقيت الخطة. كيف سأصمم النظام والآلية التي ستمكنني من التعرف على هذه الرسومات. والخطة التي أريدها، لابد أن تكون محددة، لا مقترحات متغيرة مع كل اجتماع مع المشرف كما حدث في المسألة الأولى. ماذا أفعل وكيف أعرف الخطة التي ستروق للمشرف ولا يطلب تغييرها؟
تريد أن تعرف ماذا فعلت؟
لا تتعجل. ستعرف في اليوميات القادمة، ولكن دعني ألخص لك العبرة فيما قرأته: “سماعك أو قراءتك عن النقطة البحثية ليس مؤشرًا بالمرة على سهولتها أو صعوبتها، انتظر حتى تجمع العينات وستكتشف بنفسك”
نقطة البحث ٣
توقفنا في يوميات 7 عند الخطة. كيف سأضع خطة النظام الذي سأبنيه، ليمكنني من تحقيق هدف البحث، والتعرف على الكتابة العربية آليًا؟ وكيف أجعل منها خطة محكمة تكسب رضا المشرف فلا أضطر للتعديلات مع كل اجتماع؟
كنت قد اتخذت قرارًا أنني يجب أن أفهم ماذا يدور في هذه النقطة تحديدًا. وأن أقرأ عقل المشرف. وكنت قد بدأت أحضر محاضراته لطلبة الجامعة في المواد الاختيارية التي لم أدرسها قبلًا، بعد خروجي من العمل، وأستمع إلى ما يشرحه. وعند انتهاء الفصل الدراسي سافرت لعدة أيام إلى مكان هادئ، ومعي آخر الأبحاث في تلك النقطة وتطبيقها للغات الأخرى. وعدت بخطة مفصلة عما سوف أفعله لحل المشكلة، عززتها بما استشفيته من كلام المشرف أثناء المحاضرات عن مواطن الضعف فيما تم بحثه، وما لا يزال قيد البحث. وفكرت في مقترحات للحلول وحددت ما سوف أستعين به من الأبحاث الأخرى.
وفي الاجتماع التالي قدّمت له خطة البحث وكان سعيدًا جدًا. وقال “أينما تقفين فيها فأنا راض”. كنت وقتها في قمة السعادة. أخيرًا أخيرًا حددت النقطة، ومعي الخطة، وجمعت العينات. سأنطلق دون عوائق لأول مرة منذ سنوات.
ثمانية شهور كاملة كنت أعمل فيها بدون توقف 12 أو 14 ساعة يوميًا، كنت أحلم بالمشكلات أثناء نومي، وأفكر في الحل. أحتفظ بورقة وقلم بجانب سريرى، فربما تأتينى فكرة فأكتبها قبل أن أنسى. أقفز من سريري وأجري على حاسبي كل يوم، لأتابع نتيجة تجربة أو أجرب واحدة جديدة.
مررت بكل الأخطاء المشهورة للباحثين:
- أن تخطئ خطأً فادحًا يحسّن النتائج لدرجة غير منطقية ثم تعود فتكتشفه وتعيد عمل أسبوع أو اثنين.
- أن تطحن ذهنك في محاولة تكوين معادلة أو دالة تمكنك من تمثيل نقاط البيانات وتفرح بنفسك جدًا لأنك اهتديت لها، ثم تكتشف بالمصادفة أثناء البحث أنها طريقة مشهورة ولها اسم لكن كلمات بحثك المفتاحية ما كانت لتهديك إلى تلك المصادر التي ستجدها فيها.
- أن تختار قيمًا عشوائية لمتغيرات تجربة ما ثم ترسم رسمًا بيانيًا فلا تستطيع تفسير ارتفاع وانخفاض النتائج.
- أن تُحكِم تحسين نتائجك على بعض العينات وعند تغيير العينات تجد أن نتائجك اختلفت لأنك قد أفرطت في التحسين على حساب التعميم.
- أن تأخذ نتائجك من تجربة واحدة دون تكرارها للتأكد من سلامة إجراءات التجربة وثبات الحل.
وغيرها من الأخطاء. أعتقد أنني لم أترك خطأ لم أفعله. لدرجة أنني كنت قد بدأت أشك في نفسي عندما بدأت النتائج الأخيرة تتحسن!
كل ذلك ومشرفتي تتابعني وأنا مختفية تمامًا عن مشرف الجامعة. حتى أنه قلق علىّ. فأرسل إلي يسألنى “ماذا بك؟ هل تركتي البحث العلمي؟”
تضحك طبعًا! لأنه اعتاد على الضوضاء والجلبة التي أحدثها في حياته.
إلى أن قابلت مشرفتي يومًا وأريتها ملفات النتائج، فكانت سعيدةً بها وقالت “هذا يكفي فلننه البحث على ذلك”. وبقي أن أعرض الأمر على مشرف الجامعة الذي لم أره منذ 8 أشهر. أتراه سيوافق على إنهاء البحث وإجراء المناقشة؟
تريد أن تعرف ماذا حدث؟
ستعرف في اليوميات القادمة، ولكن دعني ألخّص لك العبرة فيما قرأته: “اعرف فيمَ يفكّر مشرفك وكيف يرى الأشياء من وجهة نظره، قبل أن تضع أنت وجهة نظرك ومقترحاتك للحل. بعبارة أخرى استمع قبل أن تتكلم”
المناقشة
توقفنا في يوميات 8 عند تحسن نتائجي وقبول مشرفتي أن ننه البحث عند هذا الحد. وبقي وقتها أن أذهب للمشرف الجامعي الذي لم أقابله منذ عدة شهور، لأشرح له ما وصلت إليه، وأريه النتائج التي حصلت عليها. حددت موعدًا، وذهبت، ولم أكن قد أعددت وسيلة عرض جيدة، حاملة حقيبة مكتظة بالأوراق المبعثرة، وحاسبي المحمول.
بدأت في الشرح، وهو يستمع. وأجده يقاطعني كل دقيقة ليسألنى سؤالًا يجعلنى أحدق فيه مذهولة.
نعم، تمامًا. كما توقعت عزيزي القارئ.
كان قد نسى الخطة التي اتفقنا عليها تقريبًا.
استجمعت شجاعتي، وطلبت منه الصبر حتى أنتهي من الشرح. وبعد مدة من الكلام، وعرض ملفات النتائج والجداول على الورق والحاسب انتهيت.
فإذا به يقول لي. “جميل ما أسمعه. إذن، أين هي النتائج؟”
أعتقد أنني كنت سأسقط مغشيًّا عليّ من صدمة السؤال.
وأعتقد أنني فقدت أعصابي تمامًا، حينما قال أن البحث لم ينتهِ عند هذا الحد، وأنه لازال أمامي كثير من العمل حتى يكتمل النظام، ويصبح صالحًا للتطبيق العملي (أي في صورة منتج).
قطعًا عزيزي القارئ أنت مدرك حجم الألم الذي شعرت به، بعدما كنت سعيدة جدًا، يملأني الأمل، وكنت ذاهبة إليه مهيئة أن يوافق على مناقشة الرسالة. مرت الشهور الثمانية أمام عيني كشريط فيلم سينمائى، بسهرها، وضغطها، وما عانيته في التجربة والبحث، فكدت أبكي مما قال. وكانت على وجهي كل علامات الضيق التي يمكن أن تتخيلها، لدرجة أنه نظر إلىّ ولم يجد كلامًا. ثوانٍ صامتة مرت كالساعة، لم ينهها سوى صوت ارتطام وكسر.
لا أنا لم أكسر شيئًا اطمئن.
لوحة معلقة على جدار المكتب، سطقت على الأرض، وتهشّم زجاجها. لقد أشفقت عليّ اللوحة، وانتحرت من فوق الحائط تضامنًا مع حزني.
لا أملك اتصالًا روحانيًا، ولا قوى خارقة. هو أمر له تفسير علمي، فقد اهترأ خيطها. لكن لتوقيت الحدث حكمة إلهية.
رفع هاتفه واتصل بالمشرفة، فشكرت له في مجهودي، وشرحت له متابعتها للنتائج، ولكتابة التقارير وبعض فصول الرسالة التي أتممتها. وأوصته أن يوافق على إنهاء البحث، ووعدته أن نقوم باستكمال أجزاء أكثر في الدكتوراة، لأن ما يطلبه يستوجب بحثًا طويلًا، ومجهودًا جماعيًا، ويفوق ما تتطلبه درجة الماجستير.
طلب مني الانصراف والعودة في اليوم التالي في الساعة الـ12 ظهرًا، ليوقّع على إعلان عقد المناقشة الأولى (السمينار). وخرجت من عنده غير واثقة من أني قد حصلت على موافقة، فما زالت كلماته ترن في أذني، وأشعر أننى لم أعبر عن المجهود المضني، الذي استغرقني شهورًا بلا نوم، بصورة لائقة. ورجعت للبيت باكية، منهارة الأعصاب.
استقبلتني أحضان أمي تطمئنني، وتمسح دموعي، وتمنيني بأنني قد انتهيت فعلًا، وما علىّ إلا أن أتوجه إليه في اليوم التالي بالإعلان. وقالت لي سآتي معك لأشجعك. وفعلًا ذهبنا في اليوم التالي ومعي الإعلان، وانتظرناه ولم يكن قد أتى بعد. وانتظرنا، وانتظرنا. انتظرناه ما يقرب من ساعة، قبل أن نجده يدخل المكتب، فينظر لى باستغراب ويقول “لماذا أتيتِ؟”
أعتقد أنه قد حان الوقت لأن أنتحر أنا الآن تضامنًا مع اللوحة!
كان وجهي الممتقع وقتها كافيًا الحمد لله ليتذكر سريعًا قبل أن أنطق. ووقع الإعلان، وهرولت إلى الكلية لاستكمال الإمضاءات، وتعليقه بلوحة الإعلانات، ثم إلى البيت لاستكمال الأجزاء الناقصة من الرسالة والورقة البحثية الأولى، التي حدثتك عنها قبلًا، وإعداد شرائح العرض للسيمنار.
تلك الفترة كانت صعبة جدًا، فقد بدأ المرض يشتد على أمي، ودخلت المستشفي لعدة أيام. وكنت ما بين زيارتها صباحًا والإتيان بما تطلبه، والذهاب للعمل، ثم العودة إليها، والبقاء معها، أجلس بجانبها ومعي حاسبي وألازمها حتى المساء، ثم العودة للمنزل لمباشرة أحواله، ورعاية أبي، واستكمال كتابة الرسالة، والاستعداد للمؤتمر الأول في حياتي. لكن الحمد لله حمدًا لا يوفيه فضله مرّت على خير حال.
خرجت أمي من المستشفي، وحضرت عرض ورقتي البحثية في المؤتمر، الذي وقفت فيه مرتعدة في أول مواجهة لي مع الجمهور، ومشرفي الذى يجلس في الصفوف الأولى، لكننى أبليت حسنًا على حد قولها، وأن مشرفي، الذى لم أجرؤ على النظر ناحيته رعبًا، كان مبتسمًا برضا.
مرت بعدها المناقشة الأولى بخير، وطلب المشرف بعض تعديلات طفيفة تخصّ عرض النتائج، وتشكلت لجنة المحكمين للمناقشة النهائية.
تريد أن تعرف ماذا حدث فيها وماذا عن منح الدرجة؟
ستعرف في اليوميات القادمة. ودعني ألخص لك العبرة فيما قرأت: “اهتم بعرض مجهودك عرضًا جيدًا بكل الوسائل، وإلا سيستهان بكل ما تبذله. اجعل أحد مشرفيك على علم دائم بما تفعل من وقت لآخر؛ لأنه من سيقف بجانبك في المواقف المصيرية. مشرف الجامعة لا يراك كثيرًا في العادة فتوقع دائمًا أنه ينسى تفاصيل بحثك، توقع ذلك وذكره بلطف، ولا تعتمد على أنه يقرأ كل بريدك الإلكتروني، حاول أن تقابله من حين لآخر. حاول أن يكون مشرفك من العمل على علاقة جيدة بمشرف الجامعة؛ حتى يستطيعان دومًا التوصل لاتفاق، ولكي يكون هناك ثقة بينهما”
منح الدرجة
توقفنا في يوميات 9 عند انتهاء السمينار، ومؤتمري الأول، وتشكيل لجنة المحكمين. تلك الفترة عادةً ما تكون مُزدحمة، ما بين استكمال نتائج نهائيّة، أو عمل تعديلات بالكتابة، ومتابعة شبه يوميّة مع حركة أوراقك داخل وخارج الكلية، لاستصدار موافقة على إجراء المناقشة النهائية، وتحديد موعد لها مرتبط بتاريخ موافقة أمين الجامعة.
كنت أتقلب على الجمر في تلك الفترة تقريبًا، فقد كان السمينار في ديسمبر، ودورة الورق تأخذ ما يزيد عن الشهر، وكنت أريد أن أتم المناقشة، قبل إجازة الفصل الدراسي الأول. فالباحث بقدر صبره على البحث ومتطلباته، لا يطيق صبرًا على الأعمال الكتابية والروتين الحكومي.
كنت أشبه ببهلوان السيرك الذي يتقاذف الكرات، راكبًا على عجلة، أذهب للكلية حيث سكرتارية القسم، وشئون الدراسات العليا لمعرفة متطلبات منح الدرجة، ثم أذهب للجامعة حيث شئون الدراسات العليا المركزية لمتابعة سير أوراق التصريح بالمناقشة، ثم أذهب للعمل. وأتصل بالمحكمين لأوصل لهم مسودة الرسالة وأذهب لمناقشتها معهم، وأعد الورقة البحثية الثانية، وأعد ملخصات لفصول الرسالة باللغة العربية للمشرفين والمحكمين، حتى يتمكنوا من إعداد تقارير المناقشة، وأعد شرائح عرض للمناقشة.
وأخيرًا وبعد طول انتظار، تحددت المناقشة في فبراير من عام 2007، ومرت المناقشة النهائية بسلام. وللمرة الأولى، منذ أكثر من ثلاثة أعوام، أشعر بالارتياح التام، والرضا الكامل عن كل ما مر بي، ولكنك لا تطمئن عزيزي القارئ إلا عندما تحتضن شهادتك؛ كي تصدق أنك قد انتهيت بالفعل./p>
خرجت من المناقشة وتوجهت فورًا لمكتب التصوير، لإعداد نسخ الرسالة النهائية، التي سوف أسلمها في إدارة شئون الدراسات العليا. وطبعا لم تخلو تلك المرحلة من مواقف مثيرة للأعصاب، وأخرى مضحكة حد البكاء مع موظفي شئون الدراسات العليا. أذكر منها على سبيل المثال، أنه لابد من أن تسلم نسخة من رسالتك، مع أسطوانة عليها نسخة إلكترونية من الرسالة، وقرص ممغنط “ديسك” 3.5″ Disk عليه استمارات بيانات، في المكتبة المركزية بالجامعة، والحصول على إيصال بتسليمها.
لا تتعجب! وقتها كان الديسك لازال مستخدمًا. وقد حلّت بركة الديسك فكان ذلك اليوم مشهودًا!
توجهت بالرسائل صباحًا إلى الكلية، فطلبت منّي موظفة شئون الدراسات العليا تسليم الرسالة والأسطوانة والديسك بالجامعة، والعودة إليها بالإيصال. بصرف النظر عن أنه طلب عجيب، وأعتقد أنه ليس من اختصاصي أن أفعل ذلك، لكنني وافقت. تركت سيارتي بالكلية، وعبرت الشارع إلى الجامعة، وذهبت إلى مبنى كلية الآداب، وسألت عن المكتبة وعرفت أنها في “البدروم”!
لم يكن ذلك المبنى الفخم في الجامعة قد تم بناؤه وقتها.
حسنًا، نزلت لأمينة المكتبة، وسلمتها الرسالة والأسطوانة والديسك، وطلبت الإيصال. فقالت لي “مهلًا لابد أن أتأكد”. فتحت الأسطوانة، فوجدت عليها الرسالة، ووجدت استمارات البيانات على الديسك، كما قيل لي في الدراسات العليا. قالت “لماذا لا توجد الاستمارات مع الرسالة على الأسطوانة؟ ولماذا لا توجد استمارات البيانات الإنجليزية معهم؟”. حاولت أن أشرح لها أن هذه ليست المشكلة، وأنني فعلت ما طلب مني. ولكن طبعًا كأيّ موظفة حكوميّة أصيلة، رفضت أن تعطيني إيصالًا حتى أضع الاستمارات مع الرسالة على الأسطوانة.
ولم يكن معي حاسبي المحمول، فالسيارة بالكلية. قالت لي “اصعدي إلى غرفة المايكروفيلم بالأعلى وسيساعدونك ثم عودي لأعطيكِ الإيصال”. وقتها كانت الساعة حوالي الـ 12 ظهرًا، وصعدت للغرفة المذكورة، وشرحت مشكلتي لأول موظف رأيته، فقال “نعم هذا تخصص الأستاذ إيهاب، وهو غير موجود انتظريه”. دخلت إلى مكتب الموظف المنشود، فوجدت فتاة أخرى تنتظره غالبًا لنفس الغرض وموظفة أخرى مع ابنتها الصغيرة!
كان معي نسخ ورقية من الاستمارات الإنجليزية، وكنت أريد أن أمسحها ضوئيًا وأضيفها على الأسطوانة مع الرسالة والاستمارات العربية. ولما طال انتظار الأستاذ إيهاب، ولم يظهر، استأذنت الموظفة في أن أفعل ذلك بنفسي على أحد الأجهزة، وأثناء ما كنت أمسح استماراتي، كانت الفتاة الأخرى تضع استماراتها على الأسطوانة الخاصة بها، ثم انتهت وخرجت لتسلمها. وبعد أن قامت جلست أنا لأضع استماراتي فإذا بى أفاجأ بضياع الرسالة من على الأسطوانة.
نعم، لقد كانت نسخة البرنامج معدة بحيث تكتب على الأسطوانات من بدايتها ولا تُكمل على محتواها.
نعم، تمامًا لقد توقعت ما حدث.
ما هي إلا دقائق معدودة حتى عادت الفتاة تصرخ أين ذهبت الرسالة؟.
لا تضحك! صدقني أحيانًا المواقف تكون في منتهى السوء، خاصة وإن كنت محدودًا بوقت، وقد قارب الموظفون على الرحيل، وأنك ستضطر بعد كل هذا الانتظار إلى الذهاب والعودة، وتكرار هذا المسلسل الممل مرة أخرى في يوم أخر. لحسن الحظ أننى كنت دائمًا دائمًا أحتفظ بأسطوانات احتياطية في حقيبة يدى Backup، أضع فيها آخر ما حدثته من أعمال أو ملفات. أنقذتني تلك الأسطوانات من مصير الفتاة المسكينة، التي جلست تبكي لأنها كانت مغتربة، وستسافر في اليوم التالي، فليس لديها وقت للعودة مرة أخرى. أما أنا فأعدت كتابة الأسطوانة بالرسالة، والاستمارات، وتركت الفتاة متشبثة بتلابيب الموظفة، وسلمت الأسطوانة قبل رحيل أمينة المكتبة بدقائق معدودة، وعدت منتصرة بالإيصال.
وبصرف النظر عن أنني عندما وصلت الكلية ركضًا، لأنني أريد أن ألحق بموظفي الدراسات العُليا قبل رحيلهم، وأنني وجدت الأبواب مغلقة؛ لوجود مظاهرة داخل الكلية احتجاجًا على اعتقال أحد الأساتذة، إلا أنني تمكنت من الدخول من أحد الأبواب الجانبية، وتسليم الإيصال، والانهيار داخل سيارتي.
لن أحكي عن مواقف أخرى، كالنزهة اليومية بين إدارتي الدراسات العليا في الكلية، والجامعة للسؤال على الأوراق، فلم يكن الموظفون في ذلك الحين يهتمون بالرد على التليفونات. ولن أحكي عن الشهادات التي ظللت أنتظرها لأسابيعَ، خاصّة الإنجليزية منها، واضطررت في النهاية أن أجلس لكتابتها مع الموظفة الموجودة، لأن الموظفة التي تعرف الإنجليزية في إجازة. أو أنني أخذت شهاداتي لجمع التوقيعات، والأختام بنفسي من كل موظف مختص.
ه .. ذكريات لا تُنسى. وكيف أنسى أن تاريخ المناقشة كان في 18 من فبراير، وبعد هذا الكفاح المرير، حصلت على الشهادة في 26 إبريل من ذاك العام. أي أكثر من شهرين!
ولعلك تتساءل الآن ماذا بعد؟ وهل ستعودين للشركة أم لا؟
الحقيقة أنني قررت ألا أعود، فقد مرت أكثر من سنتين على تركي للشركة، وعلمت من الزملاء القدامى أن أغلبهم قد رحل عنها، وشعرت أنني لن أحبها كما كنت بالسابق. بالإضافة إلى أنني قد وجدت شغفًا حقيقيًا في نقطة بحثي تلك، وكنت أحرص من المشرفين على استكمالها، وكنت منتشية بفرحة الإنجاز. ويكفي أن تعرف أن تلك الورقة البحثية التي نشرتها، كانت من أوائل ما نشر في تلك النقطة البحثية، رغم قصرها. فقد كانت 4 صفحات فقط، لكنني استطعت شرح عمل 8 شهور فيها، ولا يأتي ذكر النقطة إلا وتجد ذكر الورقة. وحتى اليوم هي الأكثر إشارة إليها من بين أبحاثي. تم نشرها بعد المناقشة بستة أشهر. وحتى وقت قريب كنت لا أزال أتلقى مراسلات بريدية، من باحثين آخرين يسألون عن المزيد من تفاصيل البحث.
بما تظن أنك تعرف ما حدث بعد ذلك؟ لا تتعجل! ستعرف ماذا حدث حقًا في اليوميات القادمة، ولكن دعني الآن ألخص لك العبرة فيما قرأته: ” إن أعجبك بحثك، اتبع شغفك، واجعل نيتك لله ولا تدخر جهدًا في السعي، واطمئن أنك سوف تصل لما تريده وأكثر. قم بأخذ احتياطاتٍ كافية دائمًا واحمل ملفاتك معك في كل مكان، وتابع أوراقك باستمرار بدون كلل أو ملل، وإلا ستستغرق الإجراءات زمنًا أكثر مما يستغرقه البحث.”
ما بعد الماجستير
أخبــاﺭ ثقـــافــة تعليــم مجتــمع أدب مـوارد يوميات طالب بدرجة مشرف [١١]: ما بعد الماجستيرHager 7 فبراير,2015 يوميات طالب بدرجة مشرف [١١]: ما بعد الماجستير2015-03-06T19:07:03+00:00 أدب, خــاطرة 42 تحياتي توقفنا في يوميات 10 عند انتهاء الماجستير، وحصولي على الدرجة في عام 2007. الحق أن عام 2007 كان طفرة تكنولوجية بالنسبة لي. كان هناك يوتيوب، وفيسبوك، وتحسُّن ملحوظ في محرك جوجل. أصبحت الآن أكثر راحة في التواصل مع زملائي وطلب المساعدة، وأصبحت أجد مصادرَ علمية مرئية على الإنترنت، ونتائج بحثٍ أكثر وأفضل بكثير مما سبق. وربما كان ذلك من أكبر العوائق أمامي أثناء دراسة الماجستير، لكنني لم أستفد بكل ذلك في حينها، بل تأخر ذلك بضع سنوات!
لا تتعجل فسأروي لك عزيزي القارئ ما حدث بتلك السنوات.
قد تتعجب إذا علمت أن بعد تلك الرحلة المنهكة بالماجستير، لم أرغب في أجازة طويلة، وربما لم أرغب في أي أجازة من أي نوع. كنت مشحونة تمامًا، ولا أكاد أنام. والسؤال الملح على ذهني: “ماذا بعد؟”، “ماذا بعد؟”.
أعلم أنني قد أعجبت فعلًا بنقطتي البحثية، ولدي شغف كبير ناحيتها. لكن حديث العقل كان يقول: “الآن تلك هي فرصتك الأولى منذ بدأتِ رحلة البحث في اختيار كل شيءٍ”. كل الأبواب مفتوحة وحدودي كانت السماء. يمكننى تغيير نقطة البحث، يمكنني حتى تغيير الموضوع كله. يمكنني تغيير الإشراف، بل إنني يمكنني أن أغير الجامعة بأسرها، وربما أذهب لما هو أبعد من ذلك، وأسافر للدراسة بالخارج.
ستضحك إن قلت لك أن ذلك كان يؤرقني. وقد تمنيت أن يفرض علي كل شيءٍ، فلا تتوه رأسي في الاحتمالات، ولا يرهق ذهني كل ذلك التفكير.
تحدثت كثيرًا مع عدة أشخاص. مع من سافر ومن لم يسافر، ولم أكن أسأل عن شيءٍ محدّد. كل تركيزي كان فقط على شيءٍ واحدٍ: لماذا تريد أن تفعل ذلك؟ ما هي المزايا التي تريد الحصول عليها؟ هل تستحق منك ذلك؟. لم أكن أسأل: كيف أبحث عن منحة؟ أو كيف أراسل؟ أو كيف أعيش بالخارج؟. فقط سؤال واحد: لماذا؟
لم تكن الحياة بالخارج تستهويني. لم أسمع عنها ما يجذبني إليها. لا أقول أنه لم يكن لدي طموح، لكن كان لي وجهة نظر. للمرة الثانية هنا نتحدث عن أن القرارات قد تبدو في ظاهرها اختيارات، لكنها في الحقيقة أولويات. وقد كانت أولوياتي عائلتي. لا أعلم لماذا كنت مرتبطةً بأسرتي إلى ذلك الحد. ربما لظروف مرض والدتي، أو كبر سن والداي بوجه عام. ومع تطور التكنولوجيا، أحسست أنه يمكننى تحصيل العلم وأنا بجانبهم، فلست مضطرة لتحمل أوجاع الغربة في سبيل شئ، أستطيع إدراكه وأنا في وطني. حتى أنني كنت أرفض الزواج من أي شخص يدرس، أو يعمل بالخارج، دون أن أراه حتى.
فكرت إرضاءً للفضول، أن أعرف عن الإشراف المشترك، الذي يتيح لي الدراسة هنا أغلب الوقت، وسفر قصير لعدة شهور في نهاية الوقت. لكن من سألتها لم تحمسني بما يكفي، فقد كانت لم تنته من دراستها بعد، ولم يكن لديها إجابات عن معظم أسئلتي. وسمعت عن فرصة ناشئة داخل مصر، في شكل تعاون بين أكاديمية النقل البحري وجامعة غرب ڤيرجينيا، لكنني عرفت من زميلةٍ لي أن المشروع حينها معلق، وأن واقع الأمر غير ما وعدوا به الطلبة في البداية، وأن وزارة التعليم العالي ترفض اعتماد الدرجات العلمية من هذا المشروع في ذلك الوقت، حتى أنها وبعد أن أمضت هناك أكثر من سنة ونصف السنة، تركت كل شيءٍ وراءها وسافرت في منحة أخرى إلى كندا.
أحسست وقتها أنه ربما لن أتحمل ذلك التعلق بالأمل، والشعور بالذنب بسبب البعد عن عائلتي التي تحتاجني وأحتاجها، ثم أفاجأ بتغيراتٍ ليست في الحسبان، سواء كان ذلك في منحة إشراف مشترك، أو منحة كاملة بالخارج. واتخذت قراري بالبقاء. وبدأت أسأل عن الإجراءات للتسجيل بمصر في جامعتي وكليتي. وبذلك أكون قد قلصت أسئلتي التي قضت مضجعي، لكن بقي لدي قليل من الحرية والحيرة أيضًا، في اختيار المشرفين، ونقطة البحث، إن اتخذت قرارًا بالتغيير.
كنا في شهر مارس، والتقديم للسنة الدراسية يبدأ في أغسطس. ومن يظن أن ذلك يعد متسعًا من الوقت للتفكير فهو واهم. لقد كانت فترة طاحنة. علمت أن نظام التسجيل للدكتوراه في الكلية عمومًا وفي قسم الاتصالات خصوصًا معجز تقريبًا. فعند التقدم بأوراق تسجيلك في أغسطس، لابد وأن تكون اجتزت امتحان التويفل بـ 500 درجة أو أكثر وشهادتك سارية، وأن تكون قد نجحت في امتحان القبول الخاص بقسم اتصالات، والذي لا يعلم أحدٌ ما هو تحديدًا، فقط يعلمون أنه في يونيو، وأن تكون قد استقريت على لجنة إشراف، وأعددت خطّة بحثية تقدمها مع الملف، موقعة من المشرفين! هذا بالطبع إلى جانب الأوراق العادية من شهادة الماجستير، وموافقة جهة العمل على أيام التفرغ، وغيرها من الأوراق إلخ.
ماذا يحدث في تلك الكليّة بالضبط؟
“هل نعاقب على أننا نرغب في عمل دراسات عليا بمصر؟” هكذا كنت أفكر وقتها. لم أكن أعلم أن شروط الحصول على منحة دراسية بالخارج، لا تختلف عن ذلك كثيرًا.
/p>
لم يكن لدي متسع من الوقت للتفكير. إن لم أستطع أن أقدم كل الأوراق المطلوبة في موعدها، فسأنتظر سنة كاملة. لم يكن هناك وقتها نظام ساعات معتمدة، ولا فصلين دراسيين. بل لم يكن هناك دراسة تمهيدية في قسمي، وكان امتحان القبول هذا هو المعيار الوحيد للتسجيل.
أنت تتخيل الآن كم الأسئلة التي دارت في رأسي حينها.
لابد أن أستقر على لجنة إشراف، وموضوع لخطة البحث في زمن قياسي. وأن أعرف أين أماكن امتحان التويفل المعتمدة؟ ومتى يمكنني أن أسجل للامتحان؟ وكم من الوقت أمامي للاستعداد؟ وأين يمكنني أن أجد مصدرًا جيدًا للمذاكرة؟ وكيف سيكون شكل الامتحان؟. كل ذلك في كفة، والامتحان الغامض الذي لا يتحدث عنه أحد، في كفة أخرى، فكل ما يعرفونه هو موعد تقريبي!
عذرًا عزيزي القارئ إن وجدت يومياتي الآن تتخذ لهجةً أكثر جدية. ربما لأنه لم يكن هناك نفس حجم الفكاهة التي كانت في السابق، وكان توالى الأحداث والمفاجأت سريعًا.
تريد الآن طبعًا أن تعرف إجابات الأسئلة وماذا فعلت.. ستعرف إن شاء الله في اليوميات القادمة. ودعني ألخص لك العبرة مما قرأت: “فكر جيدًا فيما تريد. لماذا تريده؟ وهل تريده حقًا؟ أم أنك لا إراديًا تفعل كما يفعل الغير، ثم تكتشف فجأة، أنه لم يكن بتلك الأهمية لك. ولكن وأنت تفكر فيما ستفعله، لا تنسَ أن تفكر كيف سيؤثر ذلك على أولوياتك، وما هي عاقبة قرارك على من يهمهم أمرك، ثم اتخذ قرارك”
امتحان التويفل
توقفنا في يوميات 11 عند الأسئلة الكثيرة التي تحتاج لإجابة؛ كي أتخذ خطوات سريعة، وألتحق بالسنة الدراسية القادمة. في البداية توجهت لشئون الدراسات العليا بالأسئلة، وعرفت أن شهادة التويفل مطلوبة للتويفل المحلي، وأن الشهادة المعتد بها للتسجيل إما الصادرة من كلية الآداب، أو من معهد إيميد إيست. توجهت فورًا إلى كلية الآداب وسألت عن امتحان التويفل، وعرفت أنه يقام كل 3 أشهر مع نهاية دورة الشرح لمنهج التويفل، وأن أقرب موعد للامتحان في شهر أبريل.
ألا يذكرك ذلك بشيء؟
نعم، فأنا لم أحصل بعد على شهادة الماجستير! أي أن تلك الأحداث موازية للأحداث التي رويتها من قبل في يوميات 10
لم يكن أمامي الكثير. على ما أذكر 5 أو 6 أسابيع بحد أقصى قبل الامتحان. بفضل الله استطاع أن يحصل أخي من أحد أصدقائه، على أسطوانات تمارين وامتحانات Longman وCambridge. وكان لدى أخي كتاب تأهيل للامتحان. والحمد لله أن مستواي في اللغة الإنجليزية كان لا بأس به حسًّا، وممارسةً، فلم أعانِ في الاستعداد لكل أجزاء الامتحان، وركزت فقط على تعويض نقص المفردات لديّ.
لم تكن تلك فترة سهلة بالنسبة لي أيضًا. ليس فقط بسبب المفاجآت اليومية الغريبة التي أكتشفها كل يوم، والقرارات المصيرية السريعة التي يجب أن أتخذها، والإجراءات الكثيرة، والأوراق التي لا تنجز من أول مرة، والرحلات المكوكية بين البيت والكلية والجامعة، وطبعًا مسئولياتي الشخصية بالمنزل، ولكن أيضًا لأن والدتي بالمستشفي مرة أخرى.
كنت كالعادة أحمل حاسبي المحمول صباحًا وأذهب إليها بالأغراض التي تطلبها، ثم أخرج للعمل، ثم أرجع إليها مرة أخرى ألازمها حتى المساء، ثم أعود للبيت لأباشر المنزل وأقضي حاجات والدي وأذاكر، ثم أنام لأعاود الكرة صباحًا.
كنت معروفة في المستشفي، بالفتاة التي تأتي للمذاكرة مع والدتها.
دخلت الامتحان، وخرجت منه راضية، وأشعر أنني قد أبليت حسنًا. وعرفت أنني سأحصل على الشهادة في غضون شهر، فتركت ذلك الأمر جانبًا وتابعت باقي الخطوات: شهادة الماجستير التي لم تصدر بعد، السؤال عن الامتحان المجهول وكيفية الاستعداد له، التفكير في قرار لجنة الإشراف وخطة البحث إلخ.
كنت لم أفلح بعد في الحصول على أية معلومات تخص امتحان القبول: لا الأساتذة المسئولون عنه، ولا فيمَ تكون الأسئلة، ولا مدته، ولا موعده المحدد، ولا حتى نسخة من امتحان العام السابق، الذي كان أول امتحان من ذلك النوع. لم يكن لدي شيء أفعله سوى الانتظار. خلال ذلك الوقت تأملت خزانة الكتب، فوجدتها ستنفجر من كم الأوراق والكتب التي كنت أحتفظ بها منذ السنة الإعدادية بكلية الهندسة، أي ناتج ما يزيد عن 8 سنوات من الدراسة. فقررت أن أتخلص من الأوراق التي لا تعنيني كأوراق الدروس والملخصات في المواد التي لم أعد أدرسها، وانتهى أمرها فلم أتخصص بها في مجال دراستي العليا، كالإلكترونيات والموجات والتحكم، ومواد من خارج القسم كنا ندرسها كالهندسة المدنية والميكانيكية وكهرباء القوى، وبعض مواد الحاسب كشبكات الحاسب واتصالات الهواتف المحمولة الخ. واحتفظت بالكتب فقط.
تتساءل في نفسك ولم تروين هذه الأحداث؟ ثم تخطر الآن في بالك خاطرة وتبتسم.
تمامًا، كما توقعت عزيزي القارئ!
بعدها بأيام قليلة في بداية شهر مايو، قابلت رئيس القسم لأسأله عن امتحان القبول، وعرفت أن الامتحان هو امتحان قياس مستوى في كل مواد القسم التخصصية وبالتحديد مناهج السنة الثالثة والرابعة!
وماذا يعني ذلك؟
يعنى أن الامتحان في منهج سنتين دراسيتين في خمسة فروع: الإلكترونيات، والحاسبات، والموجات، والتحكم، والاتصالات.
شعرت بشعور من تلقى للتوّ حمامَ ماء مثلج في عز الشتاء. وتعلمون ماذا أيضًا؟ لم يتبقَّ على الامتحان سوى 6 أسابيع.
تريد أن تعرف ماذا حدث بعد ذلك؟
ستعرف في اليوميات القادمة. ودعني ألخص لك العبرة فيما قرأته: “لا تتوقف عن السؤال مهما حدث، اسأل أي شخص وكل شخص. لا تطمئن لظنك، فالحياة تحمل من المفاجآت ما لا يمكن أن يخطر على بالك. وطبعًا لا تُلقِ بأوراقك القديمة حتى لو اضطررت لترك بيتك لها، والنوم في الشارع”
امتحان القبول
توقفنا في يوميات 12 عند المعلومات التي عرفتها أخيرًا عن امتحان القبول، وصدمة أنني سأمتحن في تفاصيل مواد دراسية، كنت قد تخلصت للتو من أوراقها وملخصاتها، والتي كانت الحل الوحيد لإنقاذي في هذا الظرف.
باقي 6 أسابيع. أتدري ماذا يعني ذلك؟
ذلك لا يعني فقط أنني لابد أن أقاتل لأحصل على أوراق وملخصات كتلك التي تخلصت منها للتو، ولكن الأصعب هو أن أحاول استعادة فهم مواد لا أعرف عنها شيئًا منذ 4 أو 5 سنوات!
لا تسألني ما علاقة ذلك بالتسجيل للدكتوراه؟ ولا لماذا يتم امتحاني في مواد لم أتخصص بها في الماجستير؟.
على الفور أطلقت صيحات الاستغاثة عبر فيس بوك، لعلي أجد من زملائي من لا زال بمصر، ولازال يحتفظ بتلك الأوراق. وقد أكرمني الله ببعض استجابات سريعة، فاستطعت أن أجمع قدرًا معقولًا من المصادر، تعاونني إلى جانب الكتب التي كنت لا أزال محتفظةً بها، ولكن ليس لدي الوقت لقراءتها.
أتدري ما هو أغرب من ذلك الامتحان؟ . نظام التقييم.
إن هذا الامتحان كان من 20 درجة فقط، ولا زال هناك 30 درجة أخرى توزع على النقاط الآتية:
- من أين تخرجت؟
- ما تقدير تخرجك؟
- كم مضى على تخرجك؟
- من أين منحت درجة الماجستير؟
- كم من الوقت مضى منذ انتهائك من الماجستير؟
- أين تعمل؟ (جامعة – مركز بحثي – جهة أخرى)
لكن النجاح في الامتحان ملزم، حتى وإن كنت قد حققت مجموعَ درجاتٍ عالٍ فيما سواه. عرفت تفاصيل التقييم هذه، من زميلة سابقة من الكلية، رأيتها بالصدفة في ذلك التوقيت في عملي، جاءت لزيارة شخص ما. وللصدفة البحتة كانت قد دخلت الامتحان السابق (أول امتحان)، وكأن الله أرسلها إلي لأفهم كل تفاصيل الأمر.
طبعًا لم يكن لديها نسخة من الامتحان؛ لأن الإجابة كانت في نفس ورقة الأسئلة!
لم أشغل بالي وقتها ما سرّ أسلوب التقييم الغريب هذا؟، وما سر هذا الحرص على عدم انتشار الامتحان؟ فقد كان كل تركيزي على المرور بسلام من ذلك الامتحان؛ حتى أستطيع التسجيل للدرجة. لأن هذا الامتحان لا يقامُ إلا مرتين سنويًا، وكان الامتحان التالي في فبراير، مما يعني أنني لن أستطيع اللحاق بهذه السنة الدراسية.
استعديت ما استطعت، ودخلت الامتحان، ساعتين أو ثلاثة لا أذكر بالضبط، ما بين أسئلة نظريّة ومسائل، وكنا 7 طلاب بالامتحان، وأعتقد فيما أذكر أنه عندما ظهرت النتيجة في أغسطس، عرفتُ أن 3 فقط وأنا منهم، قد اجتزناه بنجاح.
وبالنظر الآن إلى تلك الأحداث، يبدو لي جليًّا أنه كان المقصود تحجيم عدد المتقدمين للدكتوراه بالقسم، وقصره على خريجي القسم، الحديثي العهد نسبيًّا لأن المقررات تتغير مع الوقت، وأن يكون شخصًا جادًا، لم يتوقف بعد دراسته للماجستير.
صرف النظر عن رأيي في ذلك الأسلوب، فقد انتهى العمل به بعد سنتين تقريبًا من ذلك التاريخ. وصار هناك منهجا تمهيديًا، ونظام ساعاتٍ معتمدة. الحسنة الوحيدة في مرورى بهذه التجربة، هو أنني استطعت إفادة زملائي ممن خاضوا نفس الامتحان بعدي، بالنصيحة ومصادر للمذاكرة.
نعود الآن للخيارات المفتوحة أمامي، دخلت الامتحان وانتظرت النتيجة، وقد اقترب شهر يونيو على الانتهاء، وأمامي شهر لتحديد المقترح البحثي، واختيار المشرفين، وأخذ تصديق منهم عليه. الحق أقول أن شهرًا كان مدة مستحيلة، لإعداد خطة بحث مقبولة عن موضوع جديد لا أدرى عنه شيئًا. فخطة البحث ليست مجرد مسح لموضوع ما، والأبحاث التي تمت، وآخر ما وصلت إليه التجارب – فحتى ذلك سيستغرق أكثر من شهر- ولكنه يتضمن أيضا خطة مستقبلية، وشرح للأدوات المستخدمة، ومراحل البحث التي ستقوم بها بشيء من التفصيل.
استسلمت لواقع أنّه لا وقت للتجربة، كما أنني فعليا أحببت نقطتي البحثية في الماجستير، فلم يكن هناك دافع لتغييرها. كما أنني لم أصطدم بالمشرفين في خلافات شخصية، وأن كل المواقف التي حدثت وأثرت علىّ سلبا كان لها سببٌ واحد، أنني كنت لازلت أتعلم، وغير مدركة للأخطاء التي أقع فيها، سواءً على مستوى البحث أو المعاملات. وأنني إن كررت التجربة مع نفس فريق الإشراف، بخطة واضحة من اليوم الأول، فإن ذلك سيختصر عليّ الكثير من الوقت، كما أنني سأتلافى كل الأخطاء التي وقعت بها بالفعل؛ فقد فهمت أسلوب المشرفين في التفكير، واستطعت أن أعرف ما الأشياء التي يوافقون عليها، وما تلك التي يرفضونها.
تواصلت معهما، مشرفتي من المركز البحثي، ومشرفي من الجامعة، وطلبت منهما الموافقة على الاستمرار في الإشراف علىّ، واستكمال البحث، وإضافة ما لم نُضِفه في رسالة الماجستير. فوافقا، وقضيت شهرًا في البحث والقراءة، أعدّ خطةً ثريّة مدعّمة بالمصادر عن مراحل البحث، وتفاصيلها، وقام المشرفان بتوقيعها.
الآن حصلت على كل الأوراق والشهادات المطلوبة، وظهرت نتيجة امتحان القبول في بداية أغسطس ونجحت به أيضًا. وأصبح الملف كاملًا أخيرًا، وقمت بالتسجيل في موعده، وتنفست الصعداء.
ربما تظن أن الجزء الأصعب قد انتهى، وأن كل شيء سيسير حسب الخطة الموضوعة، كما يقولون في الأفلام السينيمائية.
تريد أن تعرف ماذا حدث؟ وما الذي تغير؟
لا تتعجل! ستعرف في اليوميات القادمة. ودعني ألخص لك العبرة مما قرأت: “كن مبادرًا، ولا تنتظر المعلومة تأتى إليك، حتى وإن كنت لن تتخذ الخطوات الآن. تلك المبادرة هي جزء من السعي الذي يستجلب عون الله لك. استعن بالله ولا تعجز كما قال رسول الله (ص)، ولا تشغل بالك بتفسير أو تحليل الأحداث في حينها، فالأحداث ستفسر نفسها لاحقًا”
الامتحان الشامل
توقفنا في يوميات 13 عند إتمام أوراق تسجيلي، والقرار بأن أستمر في نفس نقطة بحثي، مع نفس فريق الإشراف. وكما هو معروف فإن هناك ما يسمى الامتحان الشامل، يمتحنه طالب الدكتوراه، للتأكد من صلاحية خلفيته العلمية لدرجة الدكتوراه. وحسب لائحة الجامعة، فإنه يحق للطالب دخول هذا الامتحان، بدءًا من مرور 6 أشهر على تاريخ تسجيله للدرجة، وحتى سنة ونصف السنة (18 شهرًا). وأن لديه الفرصة لإعادة الامتحان مرتين، إذا لم ينجح في المرة الأولى.
وفي الواقع، فإن الكلام قد يبدو فيه حرية، لكن الواقع لا. فالامتحان يقام مرتان سنويا في القسم، مرة في يناير، وأخرى في يوليو، ومعني ذلك أنك إن انتظرت لأكثر من ستة أشهر بعد التسجيل، فإنه لن يكون لديك سوى فرصة واحدة للإعادة إن لم تنجح في المرة الأولى، قبل أن تنتهى مهلة الـ 18 شهرًا، وإن أجلته لنهاية المدة، فلن يكون لديك أي فرصة في الإعادة، إن رسبت.
أراك متعجبًا تتساءل: لماذا تتكلمين دومًا عن الرسوب والقلق منه وأنتِ متخرجة بامتياز؟
الحق أنه لا توجد بالدنيا ضمانات، وأنت تدخل مرحلةً جديدةً من حياتك مع كل درجة علميّة تحصل عليها، ولابد أن تعرف هل أنت فعلًا قادرٌ على النجاح والتفوق فيها أم لا، وفي ذلك لا يشفع لك إن كنت متفوقًا فيما قبلها، وإن كان تفوقك هذا عاملًا مساعدًا فقط، ومؤشرًا على مثابرتك واجتهادك.
حسنًا لنعد إلى الامتحان. وجدتني طبعًا أمام اختيار ليس بالاختيار. ما الذي يجبرني أن أضيع فرص الإعادة بتأجيل دخول الامتحان؟ خاصة وأن زميلة لي، أعرف أنها ذكية ومجتهدة، لم تستطع اجتياز الامتحان مرّتين متتاليتين، مما أثار القلق داخلي.
لاحظ عزيزي القارئ، أن من يحاول عمل الدكتوراه في مصر أعداد أقل بكثير من الماجستير؛ إما لأنهم يفضلون الدراسة بالخارج، أو لأن الماجستير كان بالنسبة لبعضهم وسيلةً لزيادة المؤهلات للحصول على وظيفة جيدة لا أكثر، أو أنهم لم يوفقوا فيه فبالطبع لم يكملوا مشوار الدراسات العليا. وبالتالي فإنك لن تجد الكثير ممن تعرف، يمكنك أن تسأله عن تجربته، وتستفيد من خبرته.
اتفقت مع مشرفي أنني سأؤجل العمل بالبحث حتى أجتاز الامتحان الشامل في يناير، وأنني خلال تلك الفترة سأستمر بالقراءة عن مزيد من التفاصيل التي سأحتاجها وقت البحث؛ لأنطلق فيه مباشرة بمجرد أن أنتهي من الامتحان.
سألت عن الامتحان، وعرفت أنه امتحان جماعي، ولكن بحسب تخصصك بالماجستير، فاستبشرت خيرًا، فهذا يعني أنني لن أمتحن بغير تخصصي. بعدها فهمت أنني أتبع مجموعة الاتصالات! رغم أن نقطتي البحثية هي أحد تطبيقات الحاسب، ولكن هذا طبعًا يرجع مجال دراسة السنة التمهيدية للماجستير، كما عرفت عزيزي القارئ من اليوميات السابقة.
حسنًا! وهل أستطيع الاعتراض؟ قطعًا لا .. إذًا فالصمت أفضل.
كانت اللجنة مكوّنةً من ثلاثة أساتذة لمادة الاتصالات، ومشرف الجامعة الذي اخترته للتسجيل، وممتحن خارجي من جامعة أخرى، وقد اختاروا لي أستاذة من كلية الهندسة، جامعة عين شمس. عرفت أسماءهم جميعًا، وبدأت في مقابلتهم، واحدًا تلو الآخر، لمعرفة ما المطلوب مني مذاكرته استعدادًا للامتحان.
كتفى مشرفي بأساسيات موضوعي البحثي، وكان ذلك أسهل ما في الأمر، واختارت الممتحنة الخارجية، 6 من أصل 9 فصول لكتاب في اتصالات الهواتف المحمولة. أما عن باقي اللجنة، أساتذة القسم، فقد اختار اثنان منهما، نفس مناهج السنة التمهيدية للماجستير. وستتعجب عندما تعرف عزيزي القارئ من الأستاذ الأخير؟.
إنه ذاك الأستاذ الذي أردت أن أدرس مادته الاختيارية في تمهيدي الماجستير، ولم أتمكن لأنها كانت بعيدة عن تخصص مشرف الشركة التي كنت أعمل بها، واكتشفت أثناء الماجستير بعد أن تركت الشركة وعملت بالمركز البحثي مع مشرفين آخرين، أنها أقرب لموضوع بحثي وتمنيت لو كنت درستها.
أتدري أيضًا عزيزي القارئ، فيما يريد أن يمتحنني؟
نعم، في تلك المادة نفسها.
أتدري كذلك أننا في بداية العام الدراسي؟ أتعرف ماذا يعني ذلك؟
نعم، أستطيع أن أحضر له وهو يشرح تلك المادة لطلبة الماجستير الآن!
معك حق أن تتعجب وتبتسم!
الدنيا صغيرة جدًا، والزمن يدور، والأحداث تتكرر، وما أردته ولم تحصل عليه في حينه، قد يأتيك مرة أخرى.
لطالما أحببت هذا الأستاذ رغم القسوة التي تشاع عنه. لم أعامله عن قرب قبلًا، ولكنني أقدره جدًا. درّس لي مرتين وأنا طالبة، ولا أستطيع أن أصف كم كنت مبهورة بأسلوبه المتأني الدقيق، الذي حببني بشدة في المواد التي درّسها لي. والحق أنني استمتعت بحضور تلك المادة في ذلك الوقت، ولازلت أحتفظ بكشكول المحاضرات، وأستعين به من وقتٍ لآخر حتى قبل أن ابحث على الإنترنت، أو أشاهد محاضرات على يوتيوب.
مضت الشهور، وأنا في عملى صباحًا ومساءً في الكلية، أحضر لذلك الأستاذ، ثم أعود لأذاكر مواد الماجستير، التي لا أعلم عنها شيئًا منذ أديت امتحاناتها، منذ أكثر من 3 سنوات، لأنها كما قلت سالفًا، لا علاقة لها بموضوع بحثي.
جاء يوم الامتحان، خمس ورقاتٍ أسئلة، وكراسة إجابة، وأربع ساعات متصلة بدون فترة استراحة.
لن أتحدث عن كم الارتباك الذي كنت فيه؛ لأن أحد المواد كانت أسئلتها صعبة وأخذت وقتًا أطول مما كان مقدرًا لها. ولأن مسائل اتصالات الهواتف كانت معطياتها ناقصة. ولأنني أخطأت خطأً حسابيًا في مادة أستاذي الذي أقدره، فكانت المسألة التي تحل بالطريقة العددية لا تتقارب. وسؤال من مادة الاتصالات لم أستطع إجابته، وأعتقد أني وضعت نظرية جديدة للحل، حتى لا أترك الإجابة فارغة.
يمكنك أن تضحك طبعًا، فقد كنت في وضع لا أحسد عليه.
وخرجت من الامتحان، لا أريد التحدث مع أحد، عن أي شيء. ليس لديّ أدني فكرة عن أدائي، وهل سأنجح أم لا. وكنت مُتعَبة حقًا. وأريد أن أنسى كل شيء حدث في ذلك اليوم. وأريد أن أبكي بشدة.
أتعرف ماذا حدث؟
سأقول لك في اليوميات القادمة. ودعني ألخص لك العبرة مما قرأت: “لن تتوقف عن التخطيط المستمر لحياتك، ومرور الأحداث فيها سيذهلك تمامًا. كن على استعداد، ولا تضيّع فرصك التي في يدك، فأنت لا تدرى إن كانت ستأتيك مرةً أخرى أم لا”
بداية البحث
توقفنا في يوميات 14 عند الامتحان الشامل، وخروجي منه في حالة ما بين الذهول والضيق، لا أدري ماذا فعلت، وهل سأنجح أم لا. والحق أنه لا يسعني إلا أن أسجد لله شكرًا على فضله، فقد أكرمني الله وكلل تعب الشهور الماضية بالنجاح رغم كل شيء، بفضل دعوات والداي لي. وبذلك أكون أخيرًا فرغت من كل الامتحانات، ولم يعد هناك أي عائق الآن، يحول دون بداية رسالتي، وتنفيذ مقترح البحث الذي قدمته.
وكما قررت في بداية تسجيلي للدكتوراه، أن أتعلم من الأخطاء التي مررت بها. وبدأت بالاتفاق على خطة واضحة من أول يوم مع فريق الإشراف. وتبعتها بتصميم وبرمجة أداة مساعدة، تمكنني من التعامل مع عينات الكتابة بشكل أيسر، وأسرع، فتوفر علىّ أضعاف الوقت الذي استغرقته بهذه المرحلة في الماجستير سابقًا، وبذلك تمكنني من العمل على مجموعة عينات أكبر. لم يطلب مني المشرف عمل تلك الأداة؛ لأنه لا يدرك مدى أهميتها بالنسبة لي، لكنني تعلمت من مرحلة الماجستير أمرين في غاية الأهمية.
الأول هو أنه لابد أن تعرف كيف تحل مشاكلك التقنية بعيدًا عن المشرف؛ لأنه ليس بالضرورة أن يكون قد قام بنفسه ببحث مشابه لبحثك، فبالتالي لا يمكنه أن يكتشف مشاكلك التقنية أو أن يقترح حلول لك.
والثاني هو أن المشرف يحبّ وسائل الإيضاح البصرية ذات الألوان المميزة. فمثلًا، لا تريه جدول أرقام، ولكن اشرح له على رسم بياني. اجعل لكل فئة بيانات لونًا مميزًا لإيضاح الفرق، وضع علامات وأسماء تُوضّح كل فئة من البيانات.
هاتان المشكلتان كانتا سببًا في سوء فهم كثير من نتائجي، وعدم إبراز الجهد الذي تم فيها. فقررت أن أصمم تلك الأداة خصيصًا؛ لتلافي تكرارَ هذا الموقف تمامًا.
بعد الامتحان الشامل، قررت فورًا البدء بعمل تلك الأداة. واستغرقني العمل فيها شهرين، فشعرت أنني قد تأخرت كثيرًا بدون أن ألتقي بمشرف الجامعة. فطلبت أن أجتمع به مع مشرفتي، حتى يكون على علم بآخر الأحداث. ذهبنا للاجتماع، وعرضت عليه الأداة، وشرحت له فيما سأستخدمها، ووعدته أن أبدأ فورًا في الخطوات التالية. فوجدته يعلق كثيرًا على تفاصيل الأداة، ويطلب تعديلاتٍ كثيرة بها!
حاولت أن أشرح له أن تلك الأداة لا علاقة لها بالبحث، ولكنها فقط لتسهيل مهمتي وتعجيل مرحلة معالجة العينات؛ حتى أستطيع العمل على عدد أكبر، كما كان يريد، واعترض سابقًا على قلة عددها. لكنني وجدته مصممًا على التعديلات!
لم أفهم شيئًا، حتى قال أنه يريد أن تكون تلك الأداة هي موضوع رسالة الدكتوراه!
نعم عزيزي القارئ، فهمت أنه يريد تغيير نقطتي البحثية.
الحقيقة أنني ذهلت. فالأداة هي عبارة عن محض برمجة حاسبٍ، لا تمت للبحث بأي صلة، كيف تكون موضوع رسالة؟ لم أقتنع لأنني سأمضي وقتًا في إعداد العينات، دون أن أقدم حلًا لمشكلة بحثية. فشرح أنه يريد أن تكون الأداة جاهزة بمميزات قوية جدًا، وهي قيمة في حد ذاتها لخدمة الباحثين، ثم يمكن في النهاية عمل تصنيف للعينات التي عولجت بواسطتها، وأن مسألة التصنيف تلك ستكون نقطة بحثية. وأن لى الخيار: إما الاستمرار في نقطتي البحثية، أو التحول للنقطة الجديدة التي ستكون لها موارد كبيرة من وجهة نظره.
بصرف النظر عن أنني لم أقتنع، فإنني ذهلت حينما وجدت مشرفتي تؤيد النقطة الجديدة بشدة!
أعتقد أنك فهمت شعوري. النقطة البحثية محل شغفي ذهبت أدراج الريح. المصادر التي جمعتها خلال شهور؟ والخطة التي حلمت بها، وأحكمت تصميمها؟ أنا الآن أمام قرار مصيري لابد أن أتخذه، صَمَتُّ. لم أجد ما أقوله. لقد أفقدتني المفاجأة النطق!
وفي ثوانٍ معدودةٍ وافقت مشرفتي على الفكرة نيابة عني، وأصبح الأمر حقيقةً واقعةً. سأترك شغفي الآن. سأتركه رغم أننا كنا متفقين على كل شيء منذ البداية
لا أحتاج إلى أن أقول لك ما حدث عزيزي القارئ، فأنت قطعًا تتوقعه. فقدت حماسي للأداة التي كنت أعمل بها بكل جد ونشاط حتى أنهيها وأبدأ البحث. كرهت العمل بها. البرمجة ليست هدفًا بالنسبة لي. هي فقط وسيلة لا أكثر. ليست البحث الذي أحبه وأعشقه. وبعدما انتهت التعديلات، تركتها جانبًا، وبدأت بحل المسألة البحثية التي ستستفيد من ناتج الأداة على عينات مصطنعة؛ حتى أشعر أنني أعمل بالبحث، لا البرمجة، وحتى أضع هيكل الحل للمسألة الجديدة، التي لا أعرفها، قبل التجربة على عينات حقيقية. فقد كان إعداد عينات حقيقية سيضيع شهورًا أخرى بلا طائل؛ لأنني ضخمت كمية العينات عن تلك المستخدمة في وقت الماجستير.
استغرق تعديل الأداة والعمل بالمسألة الجديدة ما يزيد عن السنة، واقتربنا من نهاية عام 2009، أي أنه مضى عامان منذ تاريخ تسجيلي، فطلبت من المشرف أن أعد ورقةً بحثية بما تمّ؛ لأن شروط منح الدرجة تستوجب نشر ورقتين. أعددت الورقة في النقطة الجديدة، وأرسلتها لمجلة متخصصة، استغرقت 3 شهور في المراجعة، ثم حصلت على رد المحكمين.
رُفضت الورقة. وجاءت ردود المحكّمين في منتهى القسوة!
لم تكن تلك في المفاجأة الوحيدة في هذه السنة.
تريد أن تعرف باقي المفاجآت؟
ستعرف إن شاء الله في اليوميات القادمة. ودعني ألخص لك العبرة مما قرأت: “من الجيد أن تتعلم من أخطائك، لكن لا تتخلّ عن شغفك، إذا وجدته فعلًا، مهما حدث”
المفاجآت تتوالى
توقفنا في يوميات 15 عند مفاجأة رفض الورقة البحثية. لا أعلم إن كان الرفض في حد ذاته هو ما آلمني، أم أن ما آلمني حقًا قسوة الردود التي جاءت عليها، أو ربما لأنني تعبت شهورًا فيما لم أحب ولم يؤتِ ثماره أيضًا. أنا أعلم أنني لم أكن شغوفة بالنقطة الجديدة، كما كان الحال مع النقطة البحثية القديمة، لكنني بوجه عام أتقن عملي قدر المستطاع، ولا أحتمل الإهمال، حتى وإن كنت أعمل شيئًا لا أحبه.
الحقيقة أنني لم أستطع استعادة توازني الذي اختل بسبب تلك المفاجأة، فما لبث أبي أن أصابه مرضٌ فجائيّ، أدخله في غيبوبة لعدة أيام، وتضاربت أقوال الأطباء حول تشخيص مرضه، وطريقة العلاج، فكانت الأسرة كلها مشلولة التفكير، وفور تحسن حالته قليلًا، ذهبنا به إلى المستشفي، التي ظلّ فيها لأكثر من شهر ونصف، إلى أن استقر رأي الطبيب المعالج على جراحة صغيرة، ثم مالبث بعد خروجه أن اكتشفنا أنها لم تكن ناجحة، فلجأنا لطبيبٍ آخر أجرى له جراحة أخرى.
وما إن أفقنا من مرض أبي، حتى اشتد المرض بأمي. وكانت تذهب في غيبوبة تلو الأخرى، فكنا نقضي في المستشفي أيامًا أطول من تلك التي نقضيها بالمنزل. نعم كنت محطمة الأعصاب من كل الاتجاهات، لا وقت ولا رغبة ولا حماس للعمل. أتنقل يوميًا بين العمل والمستشفى والمنزل، ولا أنام سوى سويعات قليلة، وأشرب القهوة بدلًا من الماء، لأظل مستيقظة أطول فترة ممكنة، وفقدت وزني بصورة ملحوظة حتى وصلت لـ 58 كيلو جرامًا، وهو ما يقل حتى عن وزني المثالي. لم أكن أبالي بنفسي أو صحتي، أو أي شيء يحدث معي، فقد كنت أعلم أن النهاية قريبة، وليس في يديّ شيء، ومتشبثة بالرجاء في الله أن يبقيها لي، فهي دعمي وسندي، وتأثيرها في حياتي يفوق كل وصف، وأعرف أن حياتي بعدها ستصبح لا تطاق. قررت أن أوقف تسجيل الدكتوراه، وأن ألزم قدميها حتى آخر لحظة، واتصلت بمشرف الجامعة وقلت له أنني سأمر عليه في اليوم التالي، لأخذ موافقته على إيقاف التسجيل ومعي شهاداتها الصحية.
لكن ذلك لم يحدث.
كان مراد الله فوق كل شيء.
حلت أمي. رحلت أثناء غيبوبتها، فلم تودعني ولم تُوصِني. لا أذكر ماذا كانت آخر كلماتها، ولا متى كانت آخر ضمةٍ منها. وما بين ليلة وضحاها أصبحت وحيدة. وانقلبت حياتي رأسًا على عقب. فمهما ادّعيت من قوةٍ وتماسكٍ، كنت في داخلي خاويةً، أشعر أن روحي صعدت معها وتركتني جسدًا بلا إحساس.
ولكن الحمد لله أن دعاني إليه. فسافرت بعدها مباشرةً في عمرة، وأنخت ناقتي المجهدة على باب بيت الله، أطلب منه الصبر والعون، ورجعت من العمرة أحاول أن أدبّر أمورَ حياتي في ذلك الوضع الجديد. فقد أصبحت الآن مكان أمي شئت أم أبيت. وما هي إلا شهور قليلة، حتى قررت أنني لن أستسلم أبدًا، وإن كنت قد تخليت عن شغفي وانكسرت نفسي مرة، فلن أسمح لنفسي بتكرارها أبدًا.
بدأت بدراسة الموقف، والبحث في السير الذاتية للباحثين الذين يعملون بنفس المجال، ورؤية تسلسل أبحاثهم ومحتواها، وقررت أن أبدأ فورًا، فقد ضاع من الوقت ما يكفي، وعدت للمربع صفر. فبدأت بنشر ورقة بحثية أشرح فيها بيانات مجموعة العينات التي أعمل عليها، وصفاتها وكيفية تجميعها، وأطرحها لمن يريد استخدامها ومقارنة نتائجها. ثم بدأت في تعديل الأداة، بحيث لا تستخدم يدويًا ويكون كل إمكانية فيها أوتوماتيكية، وتكون واجهة عرض لنظام بحثي يعمل في الخلفية، وأعددت خطة جديدة عرضتها على مشرفتي، فلم تمانع وشجعتني، خاصّةً وأنها تضايقت من رفض الورقة الأولى. وبدأت تنفيذ الخطة بالفعل. وفي غضون 3 أشهر كنت قد أعددت ورقة بحثية أخرى، أرسلتها إلى مؤتمر دوليٍّ، وقبلت للنشر، فأرسلت إلى مشرفي أبلغه أنني مسافرة للحج، وأنني أود أن أراه وأطلعه على تطوراتٍ جديدةٍ عند عودتي.
وسافرت بالفعل، وعدت بفضل الله وذهبت إليه لعرض النتائج التي توصلت إليها حتى ذاك الوقت، والخطة الجديدة التي بدأت في تنفيذها، وإطلاعه على الخطوات القادمة التي سوف ننفذها، في الفترة القليلة المتبقية والتي كانت حوالى 18 شهرًا.
ولكنني لم أكن أدري أن هناك مفاجأة أخرى في انتظاري.
ستعلمها عزيزي القارئ في اليوميات القادمة. ولكن دعني ألخّص لك العبرة فيما قرأت: “استسلامك للمفاجآت لن يمنعها من التتابع عليك، توقع ما لا يتوقع، وكن جاهزًا لأن تقف بعد كل سقوط”
ذروة الأحداث
توقفنا في يوميات 16 عند الخطة الجديدة التي وضعتها، والتي طلبت أن أقابل المشرف لعرضها عليه، وإعلامه بآخر التطورات. ذهبت بالفعل وقد حضرت عرضًا تقديميًا مفصلًا، وبدأت بالتمهيد له أن الظروف التي مررت بها كانت صعبة جدًا وأن الوقت الذي انقضى في النقطة البحثية الحالية لم يؤتِ ثماره، وأنه لابد لنا من إنقاذ المتبقي من مدة التسجيل. وشرحت له الخطة الجديدة، وكان يستمع طوال الوقت، ويسأل قليلًا. حتى أبلغته بخبر قبول الورقتين للنشر، فانقلب كل شيء.
غضب المشرف غضبًا شديدًا، وحينها من منظور الطالب كنت لا أفهم لماذا هو غاضب؟ فقد وافقت على تغيير النقطة، رغم عدم اقتناعي، ونفذت ما طلب مني دون اعتراض. وبعد أكثر من سنة تم رفض نتاج هذا العمل. والآن أقترح خطة جديدة تدمج النقطتين معًا: بالحفاظ على الأداة بمميزاتها التي أرادها، ودعمها بخلفية بحثية مستوحاة من مراحل بحث النقطة القديمة، التي كان موافقًا عليها من الأساس. ما الخطأ الذي ارتكبته لأستحق هذا الغضب؟!
وأعتقد أنني لم أفهم سر غضبه إلا الآن. فلم أعد طالبة، وأستطيع أن أتفهم الآن كيف يفكر المشرف. من منظوره كمشرف، فأنا طالبة لديه لا يراها كثيرًا. غابت عنه شهورًا طويلة، وها هي قادمة إليه بخطة مختلفة، بدأت في تنفيذها دون موافقة صريحة منه، وتزج باسمه على الأوراق البحثية، وتطالبه بتحديد الخطوات المطلوبة حسب المدة المتبقية.
فما كان منه إلا أن قال أن كل ذلك غير مقبول بالنسبة له، وأنه سوف ينسحب من الإشراف. مرّت ثوان ثقيلة، لا أدري فيها ماذا أقول أو أفعل. إلى أن استجمعت شجاعتي وواجهته بكل صراحة، أنني لا أجد عونًا كافيًا، وأنني وحيدة تمامًا. لا أقدر على تنفيذ طلباته الطموحة للغاية في كثير من الأحيان، وأنني وضعت الخطة التي أستطيع تنفيذها بالفعل في ظل الظروف التي أمر بها، مع عدم التنازل عن جودة البحث. شرحت موقفي كاملًا بكل ما أوتيت من قوة، ووضحت أنني ليس لدي مشكلة شخصية، ولم أتعمد الاختباء أو التجاهل، وأنني أحاول بكل قوتي أن أؤدي ما يطلب مني. وأنني قد تعبت وأنهكت، ومع ذلك أحاول معاندة ظروفي، والوقوف على قدماي.
هدأ قليلًا ثم قال “حسنًا من الآن فصاعدًا أريد أن أراكِ أسبوعيًا، ولا تفعلي شيئًا غير ما أطلبه”
وافقت. وخرجت من عنده في أسوأ حالاتي. وبكيت ساعات طوال. كنت أشعر بمرارة لا توصف. فقد كنت في حاجة لأي كلمة تشجيع تغيثني من الغرق، وتساعدني على المقاومة، وما تلقيته كان ثورة عارمة، حطمت عزمي.
كل ما أستطيع قوله فقط، أن ألطاف الله لم تتركني لحظة، فلم أكن أعلم ما معنى أن ينسحب المشرف الوحيد من الإشراف على رسالتي. كان ذلك يعني إلغاء تسجيلي للدرجة.
وعندما عرفت حمدت الله على أن هداني للمصارحة في وقتها، وأن أنعم عليّ بالشجاعة كي أدافع عن نفسي دون إصرار على صدام شخصيّ، كان تطوره سيقضي على مجهود ثلاث سنواتٍ من عمري.
كانت تلك الأحداث في ديسمبر 2010. بعدها عشت سنة غير اعتيادية.
تريد أن تعرف ماذا حدث؟
ستعرف في اليوميات القادمة. ودعني ألخص لك العبرة مما قرأت: “إذا اشتدت الرياح، فلا تقف في وجهها صلبًا فتنكسر، ولكن كن لينًا وانحني حتّى تمر”
سنة بلا نوم
توقفنا في يوميات 17 عند ذروة الأحداث مع مشرف الجامعة، والمكاشفة التي انتهت بإصرار منه أن أتابع معه أسبوعيًا تطورات البحث. الحقّ أنني كنت حزينة جدًا. أشعر بوحدة لم أكن أتخيلها أبدًا. مفتقدة دعمًا من نوع خاص، لم تكن تقدمه سوى أمي. أويت إلى ربي، أشكو إليه ضعف القوة، وقلة الحيلة، والهوان على الناس. وبدأت عامًا من العمل الشاق، عامًا بلا نوم.
في كل مرة أذهب فيها إلى مشرفي كانت أعصابي تتوتر. أحيانًا كنت أتمالك نفسي وأضع على وجهي قناعًا من الثبات، لكنه كان قناعًا هزيلًا، إن أخفى تعابير وجهي، فما كان يستطيع إخفاء حشرجة صوتي، أو صمتي الغير معتاد لمن يعرفني جيدًا، أو اهتزاز ساقيّ. وفي بعض أحيان، كانت الدموع تخنقني، وأحاول جاهدة ألا تنزل في حضوره، ولا يراها. كنت أشعر بضعفٍ شديد، لا يحتمل معه أي كلمة لوم أو نقد. ولكن ذلك أمر مستحيل. فإن دور المشرف الأساسي، هو النقد حتى تتعلم من أخطائك، وإن لم تعِ ذلك فلن تتعلم أبدًا.
في تلك السنة تعلمت كثيرًا، واستفدت من الطفرة التكنولوجية، وانتشار المصادر والمحاضرات على الإنترنت، فاختصرت علىّ وقتا كبيرًا جدًا في تعلم أساسيات الأدوات والطرق الحسابية، التي كنت أستخدمها للبحث، وتوفرت المصادر بشكل يفوق طاقتي لاستيعابها كلها حتى. وكلما كان المشرف يجدني أؤدي ما يطلبه، كان يطلب أن أؤديه مرةً أخرى، بطريقة أخرى، وأن أقارن النتائج، وكان العمل مكثفًا، فكانت كل مرحلة تستغرق 7 أو 8 أشهر، فخرجت من كل مرحلة في البحث بورقة بحثية منفصلة.
حتى تمّت جميع مراحل البحث، التي تعمل في خلفية الأداة التي صممناها. وكنت وقتها قد أعددت 5 ورقاتٍ بحثية، منها ما تم نشره، ومنها ما قُبِل وينتظر النشر. وكنت كالعادة أكتب باستمرار. أكتب التقارير، وأكتب فصول الرسالة بعد تمام كل مرحلة. حتى وصلت الرسالة إلى 250 صفحة، تشرحُ الأداة، والعمل الذي تمّ في هذه السنة فقط. لم أذكر عمل السنة التي قبلها، والذي رُفِض من المحكمين.
حتى كانت آخر مرحلة، وبعد أن ناقشت النتائج مع المشرف، ولم يكن لدي القدرة على مزيد من التحسين، فقال “إذًا يمكنك كتابة الرسالة”. لم يكن يعلم أني لا أستطيع العيش هكذا دون أن أدوّن كل ما عملت. فتحت الحقيبة وأريته الرسالة، فابتسم، وقال إذًا نحدد موعدًا للسمينار، فكتبنا الإعلان ووقعه، وذهبت في اليوم التالي إلى الكلية لتكملة الإجراءات، التي تسبق السمينار كما حكيت لكم سابقًا.
مرّ السمينار على خير، ومن بعده المناقشة، التي تأخرت شهرًا إضافيًا بسبب إجازة منتصف العام، وناقشت رسالتي أخيرًا في أبريل 2012.
ناقشتها بحضور الأهل والأصدقاء، وفي غياب الحبيبة، التي ما كنت أضن بأي غالٍ أو نفيس في مقابل أن تكون معي ذلك اليوم، ولكنها مشيئة الله.
لا لم تنتهِ اليوميات بعد، عزيزي القارئ.
مازال لدي ما أحكيه لك. وعبرة اليوم هى كلمة واحدة “المثابرة”
ما هي الدكتوراه؟
توقفنا في يوميات 18 عند المناقشة، وقد منّ الله عليّ أخيرًا بالدرجة، وأصبحت رسميًا من هيئة البحوث. ربما الآن لن أروي لك عزيزي القارئ، تفاصيل قصة، ولكنني سأنقل إليك خلاصة المشوار. مشوار 9 سنوات متصلة من البحث العلمي، دون إجازة أو استراحة من مفاجآت الدنيا، أو مسئوليات الحياة.
أتعرف ما هو معنى أن تكون حاصلًا على الدكتوراه؟ أتدري ما هي مسؤولياتك؟ أتعرف حتى، ماذا عليك أن تفعل بعد ذلك؟
حسنًا، غالبًا أنت لا تعرف إجابة كل تلك الأسئلة.
لكي تعرف ماذا يحدث لك على مدار مشوارك، سأضرب لك مثالًا: لنفترض أن إيجاد حل بحثي لمشكلة ما، هو “لعبة”، واسمح لى فعلًا، أن أسميها لعبة، لا بقصد اللهو، لكن بقصد الفن والمهارة.
لقد كنت طالبًا جامعيًا، وبدراسة الماجستر أصبحت تعرف “قواعد اللعبة”. لكن كان هناك دائمًا من يصمم لك اللعبة، ويقيم أدائك في اللعب. بدونه، لن تستطيع أن تلعب، أو تربح. لكنك بوجه عام، أصبح لديك خبرة اللاعب؛ لأنك حين كنت طالبًا، كنت مجرد هاوٍ مبتدئ.
في الدكتوراه الوضع يختلف، فأنت تدرس “تصميم اللعبة”، لا قواعدها، لتخرج منها محترفًا في اللعب، والتصميم معًا. يمكنك أن تصمم اللعبة التي تشاء، وتحدد كيف تدار اللعبة، وتقيم أداء من يلعبها، كما يمكنك أن توقف اللعبة، وقتما تجد أنه قد وصل لمستوى جيد في اللعب.
من البكالوريوس للماجستير، ومن الماجستير للدكتوراه. أثناء ذلك الوقت، لقد تحوّلت عزيزي القارئ، من طالب إلى باحث، ومن باحث إلى مشرف. وياله من تغيير
وهناك عدة أشياء ستكون قد أدركتها، ووعيتها تمامًا بحصولك على الدكتوراه:
أولها أنك تعلم أكثر من مشرفك. مهلًا! لا تُسيء الفهم. أنت تعلم أكثر منه في نقطتك البحثية فقط. لكن معلومات العامة عن باقي النقاط البحثية في موضوع بحثك، غالبًا قليلة جدًا، إن لم تكن معدومة أحيانًا. بعكس المشرف، الذي هو واسع الإطلاع على المواضيع المختلفة، ويعلم إلى أين تؤول الأمور في أغلب النقاط البحثية. بكلمات أخرى، دعنا نقول: أنت تملك الرؤية العميقة، بينما هو يملك الرؤية الواسعة.
ثانيًا الدكتوراه ليست نهاية المطاف، بل بداية الطريق. تعلم مهارات جديدة، وراجع معلوماتك عن الأساسيات، واقرأ عمّا لا تعرفه، ونفّذ بيدك ولا تعتمد على طالبك كل الاعتماد في تنفيذ أفكارك.
ثالثًا ليس مطلوبا منك أن تكتشف الذرة كما يقولون في الأفلام، أو تخترع جهازًا معقدًا، خاصّة وأنت تعمل لوحدك دون فريق، فمجهودك الفردي مهما كان كبيرًا، لن يصل بنتائجك أبدًا إلى مستوى فريق بحثي مختلف الخبرات والتخصصات، يعمل مجتمعًا من أول يوم لآخر يوم، لمدة خمس سنوات هي مدة عملك بالدكتوراه.
رابعًا ساعد غيرك بالمشورة العلمية، والأخلاقية أيضًا. اختصر عليه طريقًا وعرًا، وأخطاءً فادحة، وجنبه مصادمات شخصية. خصص وقتًا تنشر فيه علمك، حتى وإن كان قليلًا، ولا تخش أن ينافسك الآخرون، فأرض البحث خصبة غنية، وإن خشيت على نفسك، فذاك يعني أنك لا تريد أن تطور منها.
خامسُا كن على خلق، سواء أكنت طالبًا، أو مشرفًا. لا تعتبر كل نقد من مشرفك محاولة لهدمك، أو استخفافًا بك وبمجهودك؛ فدوره هو توجيهك للخطأ، لا تهنئتك على الصواب. ولا تعتبر ذلك موقفًا شخصيًا منك؛ لأنك إن فعلتها، فستتحول الأمور لذلك بالفعل، نتيجة ردود أفعالك الخاطئة. ولا تدر ظهرك لمشرفيك بعد الدراسة، أو بوجه عام لا تدر ظهرك لأي شخص، ستتعجب من دوران الزمن، ولقائك بهم مرة أخرى، بل وربما احتياجك لهم أيضًا. حافظ دومًا على علاقات جيدة مع الجميع، وكوّن شبكة علاقات قوية متنوعة.
سادسُا إذا كان الهدف من الدكتوراه أن تتعلم كيف تدير اللعبة، إذًا فأنت تحاول ذلك بالفعل أثناء الدراسة، وكما قلنا سابقًا “كن مبادرًا في إيجاد حلول لمشاكلك”، واعرضها على مشرفك، وأعلمه بمزايا وعيوب كل حل، وتناقشا في كيفية التنفيذ. ولا تذهب إليه محملًا بالأوراق، والأرقام، وتطلب منه أن يكتشف الخطأ، ويقترح الحل.
بحصولك على الدكتوراه، سوف تتذكر ذلك الموقف مباشرة مع أول طالب تشرف عليه، آتيا إليك طالبًا منك أن تشرح له ورقة بحثية أو جزءًا من كتاب، أو عابسًا لمشكلة تقنية يتحدث عنها بكل ضيق، وأنت ليس لديك أدنى فكرة عمّا يتحدث عنه، وماذا يريد منك تحديدًا! ..
سابعًا لقد عرفت الآن كيف يطرح السؤال. بكلمات أخرى، عندما كنت طالبًا تشكو أن المشرف لا يجيب على أسئلتك، أو لا يقدم نصحًا كافيًا، ببساطة أنت لم تعرف كيف تطرح السؤال؛ وبالتالي فمن المتوقع أنه لا يستطيع أن يعطيك إجابة. ليست مشكلة تواصل، بقدر ما هي مشكلة تعبير عن النفس، فحالك يشبه طفلًا صغيرًا لم يتعلم الكلام بعد، يشكو ألمًا بداخله، أو يواجه صعوبة ما في الوصول إلى ما يرغب، ولا يستطيع التعبير عما يعانيه إلا بالبكاء، ووالداه لا ينقصهما ذكاءً ولا فطنة، لكنهما لا يفهمان لماذا يبكي تحديدًا، فمرة يأتيانه بطعام، ومرة يدثرانه بغطاء، ومرة يربتان على كتفه، وكل تلك الحلول المقترحة لا ترضي الطفل؛ لأنها لم تعالج مشكلته. هو غاضب لأنه يعاني، وهما لا يفهمان ما المشكلة.
ثامنًا ستختلف اهتماماتك وأولوياتك فبعد أن كنت طالبًا لا يدور بذهنك سوى حلول لمشكلة بحثية واحدة الآن ستكون مشرفًا على بحث طالب أو أكثر وسيكون مطلوبًا منك للترقي في مهنتك أن تتوسع في نشر خبرتك وعملك والاتصال بالصناعة في هيئة مشاريع ومخرجات بحثية صناعية وقد يكون المشروع الذي تعمل به من اقتراحك فتكون مثقلًا بأعمال الإدارة ومشكلات التنفيذ أو ربما تنتدب للتدريس الأكاديمي أيضًا فيصبح لديك طلبة وأعباء تدريسية أيضًا. سيتوزع وقتك بين الجميع وستذكر شكواك وأنت طالب حينما كنت تغضب من أن المشرف لا يعطيك وقتًا كافيًا أو يهمل سماع شكواك. حسنا هو كافٍ بالنسبة لكل أعبائه لكنه لم يكن كافيًا في منظورك كطالب.
تاسعًا الحفاظ على سمعتك البحثية. ستدرك بحصولك على الدكتوراه، أن الدراسة النظرية دون تطبيق عملي هى محض هراء، وأنك قد وضعت قدمك على أول السلم، ولازال أمامك الكثير لتفعله. وسوف يتغير تفكيرك وهدفك من مجرد نشر ورقة للحصول على درجة علمية، إلى خطة صناعية تخرج بمنتج يصلح للتسويق. وماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لابد أن تكون أبحاثك قوية، وأن يكون لديك فريق عمل، حتى وإن لم يكن الفريق يعلم أنه فريق! ببساطة ستوزع خطتك على أكثر من طالب، يعملون عليها كنقطتهم البحثية، على التوازي أو على التوالي، ثم تقوم أنت بتركيب قطع البازل Puzzle تلك لتتم رؤيتك.
ولكن عزيزي القارئ، هذا لا يعني أبدًا أن نعطي المشرف كل العذر إن أهمل في التوجيه نفسه، ومتابعة خطى طالبه وتقدمه. فالمشرف يعلّم الطالب الاعتماد على نفسه، وملك زمام الأمور، وقيادة طريق البحث، وهذه أمور لا تأتي وحدها، وتحتاج لتوجيه من نوع خاص، لا يفقه أساليبه إلا المشرف.
ولا تتوقع عزيزي القارئ أن المشرف شخص واثق تمام الثقة في نفسه؛ فهو يتحدى نفسه مع كل تجربة إشراف جديدة، فالطلاب يختلفون، ومواضيع البحث تتغير، وما كان البحث ليسمى بحثًا إن كنا واثقين فيما سنحصل عليه.
فكر عزيزي القارئ في المواقف التي حدثت معك، وانظر إليها الآن من منظور مختلف، وتذكر انفعالاتك وردود أفعالك، ولياليك التي قضيتها في الشكوى، وربما البكاء، وأنا واثقة من أنك ستبتسم.
لم أنتهِ بعد. لا زال لدي ما أحكيه، فانتظروني في يوميات 20.
الخبرات لا تتوقف أبدا
توقفنا في يوميات ١٩ عند معنى الحصول على الدكتوراه، وكل الأشياء التي ستدركها، وتنظر لها من منظور مختلف، بعد حصولك على الدكتوراه، ووقوفك موقف المشرف، لا الطالب.
سأحكي مواقف متتالية، لبعض الخبرات التي مررت بها بعد الدكتوراه، لتعرف مزايا وعيوب هذه الخبرات بالنسبة لك.
الأعمال الإدارية ورغبة التغيير:
فبعد حصولك على الدرجة رسميًا، عادةً ما يتم إسناد العديد من الأعمال الإدارية إليك، وغالبًا إن كنت أحدث عضو حاصل على الدكتوراه، فإنك تكون أكثر من يكلف بتلك المهام. هذه الأعمال بلا شك تستغرق وقتًا طويلًا، وستزيد احتكاكك بالزملاء بشكل مبالغ فيه، وإن كنت من النوع الخجول أو العصبي فستؤدي هذه المهام إلى نشأة كل خلافاتك المستقبلية داخل عملك، ولكن المنفعة القوية منها، هو أن تعرف كل ما لم يكن مسموحًا لك أن تعرف تفاصيله، قبل أن تكون عضو هيئة بحوثٍ: كلوائح تنظيم العمل وقوانينه، والماليّات، إلخ.
زيادة المعلومات تلك، ستؤدي بك أحيانًا، إلى نتيجة طبيعية، وهي اقتراح تغييرات لتحسين سير العمل، أو رفع مستوى الباحثين، أو مشاريع لخدمة مؤسستك. يؤسفني أن أنصحك بألا تبادر، ولكن شارك إن كانت تلك المحاولات قائمة بالفعل. فعن تجارب استمرت في تلك المحاور الثلاثة لمدة عامين، فإن رغبةَ التغيير أمر لا يلقى قبولًا لدى أغلب الناس، والخوف منه يؤدي لتعثرك في عددٍ لا بأس به من العراقيل، غالبًا ما تفقد حماسَ المبادرة مع الوقت. أمّا إن كنتَ سعيدَ الحظ، وبالفعل كان هناك تغيير يجري في أرجاء المكان، فادعم ذلك التغيير بقوة، ولا تدّخر جهدًا في مساندته، لعل الله يكتب لك التوفيق.
خبرة التدريس:
أحيانًا ترغب في تجربة خبرة التدريس (إن كنت عضوًا هيئة بحوث)، سواء أكنت تعلم أنك قادر عليها أم لا، وقد قمت بذلك لسنةٍ واحدةٍ في إحدى الجامعات الخاصة، وبصرف النظر عن مستوى الطلبة، فإن معايير التجربة بالنسبة لي كانت مختلفة. تلك السنة الدراسية، لم أستطع أبدًا أن أعمل بالبحث؛ فتحضير مواد الشرح كان يستهلك الوقت بشكل غير اعتياديٍّ بالمرّة، ناهيك عن أعمال جانبية كوضع أعمال السنة، والتمارين، وتصحيح الأوراق، ورصد الدرجات، وامتحانات الإعادة. كل ذلك كان صداعًا مزمنًا، ووقتًا مهدرًا، لا أجد فيه أيّ نوع من الإبداع، لكن الميزتين القويتين في التدريس الجامعي، هو تنمية مهارة الشرح، وتبسيط أساسياتِ المادة، وتنمية مهارة الخطابة والارتجال والعروض التقديمية.
العمل بالصناعة
الانخراط في العمل البحثي دون الارتباط بالصناعة، يعد أمرًا سيئًا للغاية، إن أجبرتك الظروف عليه؛ فإنك عاجلًا أو آجلًا ستكون في احتياج للتواصل مع المهندسين، والمبرمجين المحترفين، والتعاون معهم لعمل منتج صناعيٍّ (مهما كان تخصصك البحثي). وكل يومٍ تبتعد فيه عن الصناعة، يضافُ حجرًا فوق حجر، ويبنى سدًا بينك وبين أهل الصناعة. هدم هذا السد ومحاولة التواصل أمرٌ ليس بالسهل، ستجدُ مشكلة تواصل عميقة بينك وبينهم؛ فأنتما تتكلمان لغتين مختلفتين تمامًا، ونقاط الالتقاء أحيانًا تكون شبه منعدمة. ولكن شئت أم أبيت، فستضطر لهدم ذلك السد، وردم هوة التفكير بينك وبينهم؛ حتى تقدم عملًا نافعًا للمجتمع.
كانت لي تجربة في العمل مع مشرفي على أحد المشاريع البحثية الصناعية بعد الدكتوراه. قد تستغرب كيف كنت متوترة جدًا أثناء الدكتوراه، والآن أعمل معه في مشروع. قلت لك ألا تأخذ خلافات الرأي بمحمل شخصي. وأن بعد الدكتوراه، تتغير نظرتك تمامًا لكل الأحداث التي مرّت، ففي أحد المواقف الفارقة في حياتي، وجدت مشرفي يدافع عني بجملة أثلجت صدري، لم أتوقع سماعها منه أبدًا، إذ قال: “لقد أشرفت في حياتي على عدد كبير جدًا من الطلبة، وقلما يقابل المشرف طالبًا يعتز أنه قام بالإشراف عليه، وراندة ستكون إضافة لأي مكان تعمل فيه”. بعدها بفترة قليلة كنت أتحدث إليه، أستشيره في أمر يخصني، فعرض علىّ الانضمام لذلك المشروع، فوافقت. وعملت معه لسنة كاملة. والحقيقة أن العمل بالصناعة ممتع، ولكنه يواجه تحديًا كبيرًا. فأنت دائمًا تحت ضغط مواعيد التسليم، وتخشى المفاجآت غير المتوقعة في كل لحظة. هذا الضغط قد يؤثر سلبًا على إبداعك في إيجاد الحل أحيانًا، وإذا استسلمت لذلك فسيتحول الأمر شيئًا فشيئًا إلى عملٍ روتينيٍّ تفقد فيه حماسك. وهناك عامل آخر يؤثر على اتخاذ قراراتك، ألا وهو وجهة النظر الإدارية للمشاريع، فالموارد ليست دائمًا متوفرة، وتوفيرها يحتاج لنظر الوقت والتكلفة، ومبررًا قويًا لإقناع الإدارة بتوفيرها.
إدارة المشاريع:
ويأخذنا ما سبق إلى نقطةٍ في غايةِ الأهمية، فليس معنى أنك تعمل بالبحث أنك لن تفكر يومًا في تغيير اهتمامك للصناعة، وشيئًا فشيئًا ستكون يومًا مسئولًا عن إدارة مشروع، يستوجب منك دراسة إدارة المشاريع بشكل احترافي، إن لم يكن ما هو أبعد من ذلك كشهادة معتمدة في إدارة الأعمال مثلًا. فالوقت حاليًا يختلف عن السابق بكثير، وأساسيات ريادة الأعمال لم تعد رفاهيةً في التعلم، أو مقتصرة على ذوي الأعمال الحرة، ومع الوقت ستصبح كل تلك الأشياء ضرورة ملحة عما قريب، ومهارة أساسية للتفوق المهني.
الشغف مرة أخرى:
الحق أنني أحببت شيئًا في كل تجربة من هذه التجارب. أحببت تبسيط المواد وشرحها، وأحببت إدارة المشاريع، وأحببت ربط البحث بالصناعة، ورؤية ناتجه على أرض الواقع وتأثيره على الناس. أحببت التغيير، وحماس المبادرات، وتصحيح المفاهيم والأفكار، وكنت أعمل جاهدة في حدود قدراتي الضعيفة نسبيًا لترك أثر في كل ذلك، ولو على فرد أو اثنين. وكنت أحلم أن أجد من يساعدني، وأن يكبر حلمي وأن أرى ذلك التغيير أمام عينيّ، ينمو ويحول حياةَ البشرِ إلى تطورٍ، ورخاء، وفخرٍ، وكرامةٍ، وقد واجهت صعوباتٍ جمةٍ، وإحباطات متتاليةٍ، وصدماتٍ كثيرةٍ، لا أدري ماذا أروي منها فلن تسعها الأوراق.
إلى أن جاءت الفرصة التي حلمت بها طوال السنتين الماضيتين، فطرحت كل تلك العوائق أرضًا. رأيت الفرصة في أبهى صورةٍ لم تخطر على بالي أبدًا. رأيتها في علماء مصر. لن أحكي لك عنها عزيزى القارئ، فطالما أنت تقرأ مقالي الآن فذلك يعني أنك تعرف من هم علماء مصر. لكنني سأصف شعوري حين تطوعت بها. لم أكن قد تطوعت بالوقت أو المهارات قبلًا، فوجدت المجال مفتوحًا على مصراعيه، وكل مكان يناديني للبذل والعطاء.
التطوع معهم لم يكن وقتًا أقضيه لأشعر بالرضا عن نفسي، أو ابتغاء صدقة، بل كان دافعًا لحياتي، وصار سببًا يجعلني أقفز من سريري كل يوم، وأول ما يطرأ على بالي: ماذا سأفعل اليوم؟ ماهو المتبقي من العمل؟ ماذا سأفعل بعده؟ أتمنى أن يسعفنى الوقت فأفعل كذا وكذا وكذا. شعور جامح يملأ الوجدان، يجعلك تعيش خارج حسابات الزمن، الثانية فيه تعادل سنين طوال، وعمرًا فوق العمر، وشبابًا لا يهرم أبدًا.
انطلقت بكل قوتي، وشاركت بكل مهاراتي وخبراتي، وانخرطت بكل وجداني، وذقت طعم السعادة الحقة للرسالة الفعلية، ليست رسالة درجة علمية، ولكنها رسالة درجة إنسانية: رسالة الاستخدام. تغيير حياة، وزرع أمل، وبعث جديد.
كنت أود أن أقول كلماتي الشهيرة “انتظروني في اليوميات القادمة”.
والحق أنني لا أدري ما الذي ستحمله لي الأيام، وهل سأكتب لكم ثانيةً أم لا.
لكنني أود أن أشكرك عزيزي القارئ أنك جعلتني أكتب لك. أتدري أن تلك هي أول مرة أكتب فيها يومياتي. ربما كتبت عن حياتي بعض مواقف لكننى لم أكتب قبلًا سلسلة متصلة. إن تجميع كل تلك التفاصيل من الذاكرة، والتفكير فيها دفعة واحدة كان أمرًا شاقًا. لم أكن أدرك أن الكتابة عن مشوار الحياة، تأخذ من الروح كل هذا القدر. العبرة اليوم هي عبرة التدبر. ستمر عليك الكثير من المواقف، ولن تعيها لأنها سريعة، لكن قراءة ما كتبته خلال تلك الأحداث ستجعل من يقينك بالله، وحبك للحياة، وتشبثك بالأمل، طبعًا أصيلًا فيك. الأزمات ستمر، وأنت ستعيش. ستعيش لتكتب قصتك. ستقرأها وتبتسم، وسيقرأها غيرك ويعتبر, لا تتخلى عن شغفك، عن حلمك، وأملك، سيأتيك بقدر حسن ظنك، وستشعر بمعنى آخر لحياتك.
لا تيأس مهما حدث. لا تحبط مهما صار. لا تعجز مهما سقطت. إنك تستعد لتحقق حلمك.